 تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا


قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 145].
قوله: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ الواو: عاطفة، واللام موطئة للقسم المقدر، أي: والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل: (ولئن أتيتهم)؛ لإظهار مذمتهم.
﴿ بِكُلِّ آيَةٍ ﴾ الباء للمصاحبة، أي: مصطحبًا كل آية، وقد تكون للتعدية، والآية: العلامة.
أي: والله لئن جئت اليهود والنصارى بكل آية شرعية أو كونية؛ حجة وبرهانًا وعلامة على صدق ما جئت به من عند الله، من الأمر بالتحول إلى الكعبة، وغير ذلك.
أي: مهما جئتهم به من الآيات الكثيرة؛ لأن الآيات لا يمكن حصرها.
﴿ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ "ما" نافية، أي: ما توجهوا إلى قبلتك الكعبة؛ وذلك لفرط كفرهم وتكذيبهم، ومخالفتهم وعنادهم وحسدهم، كما قال تعالى: ﴿ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ ﴾.
فهم يعلمون أنه الحق- كما ذكر الله- لكنهم لا يعملون به، والآيات إنما ينتفع بها من كان ضالته الحق، أما من كان معاندًا فلا حيلة فيه.. فلا جدوى في إطناب الاحتجاج عليهم، ولا مطمع في اتباعهم قبلته، ولهذا أكد ذلك بالقسم، تيئيسًا من إيمانهم.
وأضاف القبلة إليه صلى الله عليه وسلم في قوله ﴿ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ ؛ لتأكيد تميزه صلى الله عليه وسلم في قبلته عن أهل الكتاب، وإلا فقبلته الكعبة هي قبلة أبيه إبراهيم وغيره من الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام، وهي أول بيت وضع للناس، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ﴾ [البقرة: 143، 144].
﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ﴾الواو: استئنافية، و"ما" نافية ﴿ بِتَابِعٍ ﴾ الباء مؤكدة للنفي أي: وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم، أي: إن ذلك مستحيل شرعًا في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أمره بالتحول إلى المسجد الحرام، والانصراف عن قبلتهم، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم عن مخالفة أمر الله عز وجل.
وهذا إخبار من الله- عز وجل- عن ثباته صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى الكعبة، وشدة متابعته صلى الله عليه وسلم وتمسكه بما أمره الله به.
وفيه تيئيس من رجوعه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى قبلة اليهود، وإشارة إلى أن توجهه صلى الله عليه وسلم أول هجرته إلى المدينة نحو بيت المقدس؛ لأمر الله بذلك، لا متابعة منه لليهود.
﴿ وَمَا بَعْضُهُمْ ﴾ يعني أهل الكتاب ﴿ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ فاليهود لا يمكن أن يتبعوا قبلة النصارى، وهي مشرق الشمس، والنصارى لا يمكن أن يتبعوا قبلة اليهود وهي بيت المقدس والصخرة؛ لأن كل طائفة منهم تكفر الأخرى، وترى أنها ليست على شيء، كما قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ ﴾ [البقرة: 142].
وفي هذا زيادة في التيئيس من اتباعهم قبلته صلى الله عليه وسلم، ببيان شدة اختلافهم فيما بينهم حتى في قبلتهم مع أن شريعة اليهود هي أصل شريعة النصارى، والإنجيل تكملة للتوراة.
﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ هذا تأكيد لما قبله وتحذير له صلى الله عليه وسلم من موافقة أهل الكتاب في قبلتهم وأهوائهم وحاشاه من ذلك.
قوله: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ الواو: عاطفة، واللام موطئة للقسم، أي: والله لئن اتبعت أهواءهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
والأهواء: جمع هوى، وهو الميل عن الحق، والمخالفة له، بلا دليل من شرع أو عقل، بل بمجرد اتباع هوى النفس، وهو ضد الهدى، كما قال تعالى: ﴿ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾.
والهوى- يعمي ويصم، وهو مهلك مردٍ، كما قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ ﴾ [البقرة: 142] ، وقال تعالى: ﴿ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ﴾ [البقرة: 142].
﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي: من بعد الذي جاءك من العلم بالوحي من عند الله أنك على الحق، وأنهم على خلاف ذلك. العلم الذي تقوم به الحجة، كما قال تعالى: ﴿ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً ﴾ [البقرة: 143] ، وقال عز وجل: ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا ﴾ [البقرة: 145].
﴿ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ جملة جواب القسم و"إن" في قوله ﴿ إِنَّكَ ﴾ للتوكيد، و"إذًا" ظرف بمعنى "حين" أي: إنك حين اتباعك لأهوائهم من بعدما جاءك من العلم، أي في هذه الحال ﴿ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾.
واللام في قوله ﴿ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ للتوكيد، والظالمين: جمع ظالم، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، على سبيل العدوان، وهو النقص، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ ﴾.
وهو قسمان: ظلم للنفس بالكفر والشرك والمعاصي، وظلم للغير- بالتعدي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وغير ذلك، وهو- أيضًا- من ظلم النفس.
وأظلم الظلم: الشرك بالله؛ لقوله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: ﴿ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 143].
واتباع أهواء أهل الكتاب في التوجه إلى قبلتهم وغير ذلك من أهوائهم الباطلة المخالفة للحق من أظلم الظلم؛ لأنه وضع للاتباع في غير موضعه بغيًا وعدوانًا، ونقص مما يجب على المرء من اتباع الحق واطراح الأهواء.
وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتعليق الشيء على الشرط لا يلزم وقوعه، وهذا كقوله تعالى: ﴿ نْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 144].
وفي هذا كله تأكيد أنه لا محاباة لأحد من الخلق عند الله حتى ولو كان أفضل الرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم.
المصدر: «عون الرحمن في تفسير القرآن»
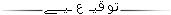
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|