 الهجرة إلى الحبشة
الهجرة إلى الحبشة


ونعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ونذكر أن قريشًا قد تكلمت في شأنه إلى أبي طالب أكثر من مرة، وأن أبا طالب قد رفض أن يسلّمه إليها، ورفض كذلك أن يكفه عنها، وأنه قد استثار نخوة بني هاشم وبني المطلب حتى آزروه ووقفوا إلى جواره، وأحست قريش أن عشيرة محمد لن تُخَلِّيَ بينها وبينه فالتفَّتْ كل قبيلة حول من فيها منهم، وراحت تعذبهم وتُنَكِّل بهم، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا سبيل إلى بقائهم على هذه الحال، فأذن لهم في الهجرة، واختار لهم الزمان والمكان، فأما الزمان فهو شهر رجب؛ لأنه هو أحد الأشهر الحرم، وأما المكان فهو الحبشة؛ لأنها إحدى أسواق قريش التجارية، ولأن فيها ملِكًا لا يُظلَم في جواره أحد، ولا يُضامُ في بلاده لاجئ أو مستجير.
وخرج من المسلمين أحدَ عَشَرَ رجلاً وأربعُ نسوة، وهم عثمان بن عفان، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وأبو سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وعامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي بن كعب، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار، وعبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زهرة، وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبدالعزى العامري، وحاطب بن عمرو بن عبدشمس، وسهيل بن بيضاء، وعبدالله بن مسعود حليف بني زهرة، والتقت هذه الجماعة بالشعيبة، ومنها إلى ساحل البحر حيث استأجرت سفينتين تجاريتين حملتهما بنصف دينار إلى الحبشة، وعبثًا حاولت قريش استرجاعهم من الطريق؛ فإنهم كانوا قد أوغلوا في البحر، ولم يَعُدْ إلى إدراكهم من سبيلٍ، ولأن هذه الجماعة قد احتوت أفصح أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأقدرهم على الجدل والنقاش، ولأن المسلمين قد أخذوا يتوافدون إلى الحبشة حتى بلغوا اثنين وسبعين رجلاً، واثنتي عشرة امرأة.
لذلك خشيت قريش أن يُفْسِد هؤلاء المسلمون ما بينهم وبين النجاشي فيُحَرِّم عليهم الاتِّجار في بلاده، وأن يدعوا إلى الإسلام ويجدوا من الحبشة الأرض التي تحميهم، والجند الذي يعينهم على فتح مكة إذا هم شاؤوا ذلك، وتمهد لهم السبيل إليه تمامًا كما فعل الأحباش مع مسيحيي اليمن ضد مضطهديهم من يهود حِمْير وملكهم "يوسف ذي نواس".
وأرسلت قريش عمرو بن العاص في رجال إلى النجاشي لاستعادة المسلمين، وعند الملك راح عمرو ورفاقه يرمون المسلمين بالْمُروق، ولكي يوغروا عليهم صدر الملك وحاشيته فقد راحوا يتهمونهم بالافتيات على عيسى وأمه، وقام جعفر بن أبي طالب فحدَّث النجاشي عن الإسلام، وذكر له ما لقيه هو ورفاقه من أذى قريش واضطهادها، وتلا عليه من سورة مريم ما أثلج صدره وهدَّأ نفسه، وجعله يقول: والله إن هذا وما جاء به عيسى لَيَخْرُجُ من مِشكاة واحدة، ورفض رجاء وفد قريش وأفهمهم أن المسلمين سوف يلقون في بلاده الرعاية والحماية وأنهم سوف يتفيَّؤون ظلال الأمن والراحة ما عاشوا بين أكنافه.
ويقول المؤرخون وكُتَّاب السِّيَر: إن النجاشي نفسه قد اعتنق الإسلام واعتنقه معه بعض حاشيته وبطارقته.
وهز موقف النجاشي هذا أركان قريش، ونَهْنَهَ من كبريائها، وراحت الأحداث تجري لصالح محمد عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخذ المسلمون يزيدون ويقوى ساعدهم، وأسلم حمزة بن عبدالمطلب، وعمر بن الخطاب، فزادهم قوة إلى قوتهم، وجعلهم يخرجون إلى الكعبة ويُصَلُّون فيها مجاهرين أمام أندية قريش، وعلى مرأًى ومسمعٍ من طغاتها وكبرائها.
المقاطعة:
وأحسَّت قريش أن الإسلام قد قوي، وأن الأيام لا تزيده إلا ثباتًا وانتشارًا، ورأت أن المصلحة تقتضي مهادنة محمد عليه الصلاة والسلام، والالتقاء وإياه في منتصف الطريق، فاقترحت عليه أن تعبُدَ إلَهَه عامًا، وأن يعبد هو آلهتها عامًا، أو أن يجمع وإياها بين عبادة إلهه وآلهتها، ورفض القرآن هذين الاقتراحين في شدة، وعارضهما في صرامة وقوة، ونزل في هذا قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: 1 - 6].
وقوله ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ * وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: 64 - 66].
وخيَّب هذا الرد آمالَ قريش في التلاقي، وقطَعَ رجاءهم في الوفاق، وأصروا على أن يقرعوا العنف بالعنف، ويردُّوا الشدة بالشدة، واتفقوا على أن يقاطعوا محمدًا وعشيرته من بني هاشم وبني المطلب، فلا يبيعون لهم، ولا يبتاعون منهم، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، ولا يدخلون معهم في تعامل مهما كان لونه، ومهما كانت قيمته، وأجمعت قريش كلها على هذه المقاطعة، وكتبوا بها كتابًا وعلقوه في جوف الكعبة.
وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب - وفيهم محمد عليه الصلاة والسلام - بطبيعة الحال إلى شِعْب أبي طالب، ولم يَشِذَّ عن إجماع العشيرة غيرُ أبي لهب؛ فإنه قد اعتزل أهله، وخرج إلى قريش، وظاهَرَها على ما صنعته، وما تعاقدت عشائرها وبطونها عليه، وطالت المقاطعة حتى بلغت عامين أو ثلاثة، وعلى الرغم من أن الطعام والميرة قد كانا يصلان إلى محمد وأقاربه سِرًّا ومن بعض القرشيين، وأن علي بن أبي طالب، وحكيم بن حزام بن خويلد قد كانا يقومان بذلك؛ فقد أضناهم الجوع، وأوهاهم السَّغَب حتى أكلوا أوراق الشجر، وحتى أوشك بنو هاشم وبنو المطلب أن يَهْلِكوا من فرط ما يعانونه من الشظف وقلة القوت، ورأى ذلك خمسة نفر من قريش؛ وهم هشام بن عمرو بن الحارث، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة، ومُطعِم بن عدي بن نوفل، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد؛ فرَقُّوا لهم، وتعاقدوا على إنقاذهم وتمزيق الصحيفة المكتوبة باعتزالهم ومقاطعتهم، واجتمعوا من أجل ذلك بخطم الْحَجُون، واتفقوا على أن يباكروا قريشًا في نواديها، وألاَّ يَأْلوا جهدًا حتى يعيدا بني هاشم وبني المطلب إلى الجماعة مرة أخرى، وأصبح الصباح، وأقبل زهير بن أبي أمية في حُلَّة له، وطاف بالبيت سبعًا واتجه إلى قريش في نواديها، وقال: يا أهل مكة، أنأكلُ الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى لا يبايعون ولا يباع منهم؟! والله لا أقعد حتى تُشَقَّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.
قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد:
كذبْتَ، والله لا تُشَقُّ. قال زمعة ابن الأسود: أنت - واللهِ - أكذبُ، ما رضينا كتابتَها حين كُتِبَتْ، قال أبو البختري: صَدَقَ زَمْعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقربه، قال المطْعِم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها، ومما كُتِب فيها، وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك، وعاد أبو جهل إلى الكلام، وقال: هذا أمر قُضِي بليلٍ، وَتُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان، وقام الْمُطعِم بن عدي إلى الصحيفة ليشُقَّها، فوجد الأَرَضة قد أكلتها إلا مكان "باسمك اللهم" وهي فاتحة ما كانت تكتب قريش، تفتح بها كتابها إذا كُتِب، ثم شُقَّت الصحيفة، وانتهت المقاطعة، وعاد النبي وأقاربه إلى حياتهم العادية في مكة.
ولم يكد الدهر يصفو له عليه الصلاة والسلام، وتنبسط أساريره في وجهه، حتى تناوحت من حوله رياح الأمس، وارْبَدَّ الجو باللوعة والحزن؛ فقد مرض عمه أبو طالب، ومرضت زوجه خديجة، وماتا معًا في عام واحد، وفَقَدَ النبي عليه الصلاة والسلام بوفاتهما الظَّهْرَ الذي كان يستند إليه من الدنيا، والصدر الذي كان يحبه ويحنو عليه، وضاق صدره عليه الصلاة والسلام، وأحس بالوحشة تعتصر فؤاده، وتملأ جوانب نفسه، وسُمِّي العامُ الذي ارتحل فيه عَمُّه وزوجه عامَ الْحُزن.
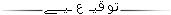
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|