 الرضا بقضاء الله
الرضا بقضاء الله


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]؛ أما بعد أيها المؤمنون:
فإذا رضِيَ الإنسان بقضاء الله صارت نفسه مطمئنَّةً، وصار هذا دليلًا على محبته لله، أما إذا تسخَّط وتشكَّى وتبرَّم، فيكون هذا دليلًا على كَذِبِهِ في المحبة، وواقعه يشهد بضدِّ ما يقول، فضعْفُ الرِّضا بقضاء الله والصبر على حكمه نزعةٌ توجد في عموم الخلق، متى ضعُف إيمان الإنسان، حتى لو لم يكن من أصحاب الأهواء والبِدَعِ والافتراء، بل قد يكون ممن ينتسب إلى السُّنَّة من يتبرَّم بقضاء الله، وقد لا يصبر الصبر الكافيَ على حكم الله، فهذا التقرير هو تذكير لأهل الإيمان والتقوى، والصلاح والاستقامة، ولغيرهم - بأن يروِّضوا أنفسهم على الرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله.
قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، والصابر لله تعالى تحت المحنة: "أجمع سبعون رجلًا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار، على أن السُّنَّةَ التي تُوفِّيَ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أولها الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره، والصبر تحت حكمه، والأخذ بما أمر الله به، والنهي عما نهى عنه، وإخلاص العمل لله، والإيمان بالقدر خيرِهِ وشرِّه، وقد ورد في الكتاب والسنة الأمرُ بالرضا بقضاء الله، والصبر على أقداره؛ قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: 22]؛ أي: إن جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كُتِبت من قبل، المصيبة في الأرض كالجدب وقلة الأمطار والزلازل، وربما يُقال أيضًا: الفتن والحروب وغيرها، ﴿ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ [الحديد: 22]؛ أي: في نفس الإنسان ذاته من مرض، أو فَقْدِ حبيبٍ، أو فقد مال، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ [الحديد: 22]، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء؛ ((لما خلق الله القلمَ، قال له: اكتب، قال: ربِّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة))؛ [رواه البيهقي وغيره].
سبحان الله! ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة، ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله تعالى؛ لأن أمر الله ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82]، لما قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمصائب التي تصيب الناس هي في أمر سابق؛ ولهذا قال: ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ [الحديد: 22].
وقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد: 22]؛ (الهاء) في قوله: ﴿ نَبْرَأَهَا ﴾ قيل: إنها تعود على مصيبة، وقيل: على الأرض، وقيل: على الأنفس، وقيل: على الجميع، والصحيح أنها على الجميع؛ أي: من قبل أن نخلق كل هذه الأشياء، وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي مدة طويلة وهذا مكتوب.
﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: 22]؛ أي: إن كتابة هذه المصائب يسير على الله تعالى؛ لأنه قال للقلم: اكتب، فكتب، وهذا يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: 22]، أرأيتم الخلائق يوم القيامة تُبعث بكلمة واحدة؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس: 53]؛ أي: على وجه الأرض خرجوا من القبور، هذا يسير والله.
ولما قال زكريا لله عليه السلام حين بشَّره بالولد: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: 8]، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: 9]، فأنا أوجدتك من قبل أن تكون، فبقدرتي أن يكون لك ولد بعد المدة الطويلة.
والله تعالى لا يعجِزُه شيء، ولا يستعصي عنه شيء، ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: 22]، ثم قال: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: 23]؛ أي: أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهي في كتاب، ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا ﴾؛ أي: لا تندموا على ما فاتكم مما تحبون.
﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد: 23]؛ أي: لا تفرحوا فرحَ بَطَرٍ واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله.
إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبلُ، فهل تندم على ما فات لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع؟ هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل؟ لا، لأنه من الله مكتوب من قبل، فَكُنْ متوسطًا، لا تندم على ما مضى، ولا تفرح فرح بطر واستغناء فيما أتاك الله من فضله؛ لأنه من الله، والإنسان إذا علِم أن كلَّ شيء مُقدَّر، ولا بد أن يقع، رضِيَ بما وقع.
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: 97]؛ قال: "القنوع".
وفي السنة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن القويُّ خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ، احرِصْ على ما ينفعك، واستعِنْ بالله ولا تعجِزْ، وإن أصابك شيء، فلا تقُلْ: لو أني فعلت، كان كذا وكذا، ولكن قُلْ: قدَّر الله وما شاء فعل؛ فإن "لو" تفتح عمل الشيطان))؛ [رواه مسلم]، وعن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ذاق طعم الإيمان من رضِيَ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا))؛ [رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح]، وعن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ((أسألك الرضا بعد القضاء))؛ [رواه الحاكم في المستدرك].
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد أفلح من أسلم، ورُزِقَ كَفَافًا، وقنَّعه الله))؛ [رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح].
ولا يتمنينَّ أحدكم الموت لضُرٍّ نزل به؛ لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه.
وعن الربيع بن أنس، عن بعض أصحابه قال: "علامة حب الله كثرة ذكره، وعلامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم الخشية لله، وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره".
فالمؤمن بقضاء الله وقدره هو الذي يرضى ويسلِّم، ويؤمن بأن هذا قضاه الله تعالى وقدَّره، ولهذا لو فتَّشت عن أولئك الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، تجدهم أمام هذه المصائب على أحوال عجيبة، فمنهم - كما هو الحال في كثير من بلاد الغرب - من ينتحر، يؤدي به حاله إلى الانتحار وإزهاق نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، ومنهم من تتحول حياته إلى حياة بائسة، ينظر إلى الدنيا وإلى الحياة نظرة مظلمة، ومنهم من يتحول وتتحول حياته إلى مرض نفسي لوجود مصيبة، لكن المؤمن بالقضاء والقدر ليس هذا حاله، ومنهم من يتحول وتتحول حياته إلى النقمة على الآخرين.
وهذه قصة تعلمنا الرضا بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوِه ومرِّه، تقول هذه القصة:
إن ملِكًا من الملوك كان له وزير صالح، لا يصيبه شيء من قدر الله - خيرًا كان أو شرًّا - إلا حمِد الله تعالى عليه، فخرجا يومًا في رحلة صيد، فعنَّت للملك ظُبية عن بُعْدٍ، فأخرج سهمًا من كِنانته ووضعها في قوسه ليرميها، فانقطع الوتر ونشب السهم في إصبعه، ثم أحدث الجرح تسمُّمًا، فأمر الأطباء بقطع الإصبع كي لا ينتقل تسممه إلى سائر اليد، فقُطع إصبع الملك، فقال الوزير: الحمد لله، فاغتاظ الملك وظنها شماتةً منه، فأودعه في السجن - وهذا هو طبع الملوك؛ يغضبون غضب الصبي، ويبطشون بطش الأسد - فلبث في السجن بضع سنين، فحمِد اللهَ تعالى هذا الوزيرُ الصالح على السجن وظل صابرًا، وفي يوم آخر انطلق الملك وحده في رحلة صيد، فأوغل في الفيافي حتى بعد عن أنظار الحرس والجند، فأسلمته قدماه إلى قبيلة مُشرِكة، على مدخلها صنم، وكان أهل هذه القبيلة قد أصابهم قحط وشدة، فنذروا لهذا الصنم إن أمطرهم أن يذبحوا له أول إنسان يقدَم عليهم، فقدِم عليهم الملك، فطاردوه وحاول الفرار فلم يستطع، فأحاطوا به وهموا بذبحه، حتى كانت المفاجأة، فعندما نظروا إلى إصبع الملك وجدوها مقطوعة، ولقد كان لهؤلاء القوم في الشرك عادات، منها أنهم لا يذبحون قربانًا إلا إذا كان لا شِيةَ فيه، فخلُّوا سبيله؛ قال أبو تمام:
وينعم الله بالبلوى وإن عظمت
ويبتلي الله بعض القوم بالنِّعَمِ
فقال الملك: الحمد لله، وهنا تذكر وزيره الصالح، فأصدر أمرًا بإخراجه من السجن وعفا عنه، ثم أحضره وقال له: أما قطع إصبعي، فقد تبين لي أنه خير، لكن دخولك السجن، كيف يكون خيرًا؟ فقال له - وكان رجلًا لبيبًا - ألم تَرَ أني لو كنت معك لأمروا بذبحي؟
فما أصابك من مصيبة في دنياك، فاحمَدِ الله على ما أصابك؛ فرُبَّ ضارة نافعة؛ قال تعالى: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، ويُذكَر أن سيدنا عليًّا زين العابدين رحمه الله لقِيَه سفيهٌ عند الحرم، بذيءُ اللسان، فقال له: يا فاجر، فقال له زين العابدين: جزاك الله خيرًا، فقال له: يا منافق، قال: بارك الله فيك، فقال له: يا فاسق، قال: هداني الله وإياك، فأراد الرجل أن يذهب، فقال زين العابدين: لقد أخبرتني عن ثلاث صفات سيئة فقط، وفيَّ صفات كثيرة أكثر مما ذكرت، أتريد أن تعرفها؟! فنظر الرجل إليه وقال: أشهد أن هذا ابن رسول الله.
إذًا: فمسألة الرضا مسألة تعود على العبد بانشراح الصدر، وعدم الرضا يجعل العبد يتسخَّط؛ ولذلك تجده قلقًا في مكتبه وهو يفكر في رزقه ورزق أولاده.
ولما شاهد قوم قارون ما نزل به من العذاب، صار ذلك زاجرًا لهم عن حب الدنيا، وداعيًا إلى الرضا بقضاء الله وبما قسمه لهم، وصاروا يرددون عبارات التحسر والندم، ويقولون: إن الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده المؤمنين وغير المؤمنين، ويقتُر ويضيِّق على من يشاء منهم؛ ﴿ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص: 82]، لولا لطف الله بنا لخسف بنا الأرض، ثم زادوا ما سبق توكيدًا بقولهم: ﴿ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [القصص: 82] إن الكافرين بنعمة الله لا يفلحون.
اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، والصبر على الأقدار، وأن تكرمنا بمحبتك، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
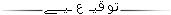
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|