 تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...
تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ...


قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 178، 179]
عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾؛ «يعني إذا كان عمدًا، الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا، حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم»[1].
ورُويَ نحوه عن قتادة[2]، ورُوي أنها نزلت في بني قريظة والنضير[3].
قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.
قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ) «يا» حرف نداء، و«أي» منادى نكرة مقصودة، مبني على الضم في محل نصب؛ لأن المنادى مفعول به، كقولك: أدعوك، و«ها» للتنبيه، و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لـ«أي» أو بدل منها.
و«آمنوا» صلة الموصول، أي: صدقوا بقلوبهم وألسنتهم، وانقادوا بجوارحهم.
والإيمان لغة: التصديق، وشرعًا: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان.
﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾؛ أي: فرض عليكم القصاص، وبُني الفعل «فرض» لما لم يسم فاعله؛ لأن الذي كتب القصاص معلوم، وهو الله عز وجل الذي فرض الفرائض، وشرع الشرائع كلها.
و«القصاص» قتل القاتل بمن قتله، بمثل ما قتله به، وعلى الصفة التي قتله عليها، مأخوذ من قصِّ الأثر، وهو اتباعه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف: 64]؛ أي: يقصان أثرهما ويتبعانه، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ [القصص: 11]؛ أي: اتِّبعي أثره، وسُمي جزاء الجاني قصاصًا؛ لأن المجني عليه يتبع أثر الجاني، فيفعل به كما فعل.
﴿ في القتلى ﴾؛ أي: في شأن القتلى، و«القتلى» جمع قتيل، كجرحى، جمع جريح.
﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾، هذا وما بعده تفصيل لما أُجمل في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾.
ومعنى قوله: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾؛ أي: الحر يُقتل بدل الحر، فيُقتل الحر إذا قتل حرًّا، ومفهوم هذا أن الحر لا يقتل بالعبد، والراجح أنه يقتل به، كما سيأتي في الأحكام.
﴿ والعبد بالعبد ﴾؛ أي: والعبد يقتل بدل العبد، والعبد: هو الرقيق المملوك، ومن باب أولى أن يقتل العبد بالحر.
﴿ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾؛ أي: والأنثى تُقتل بدل الأنثى، ومن باب أولى أن تقتل الأنثى بالذكر، ومفهوم الآية أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، والصحيح أنه يقتل بها، كما سيأتي بيانه.
﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ الفاء: عاطفة تفيد التفريع، و«من» شرطية، و«عفي» فعل الشرط، وجوابه جملة ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وما عطف عليها، وقرن الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية، والعفو: التجاوز، والمراد به هنا التجاوز بإسقاط القصاص عن القاتل، والضمير في قوله «له» يعود إلى القاتل الذي عُفي عنه، والضمير في قوله «من أخيه» يعود إلى المقتول الذي عفا وارثه عن القصاص من قاتله؛ أي: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾؛ أي: من دم أخيه المقتول.
وقوله: ﴿ شيء ﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعم أيَّ شيء، قليلًا كان أو كثيرًا.
فإذا عفا واحد من ورثة المقتول - مهما قلَّ نصيبُه - سقط القصاص.
﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾؛ أي: فالواجب على وارث وولي المقتول الذي عفا عن القصاص إلى الدية، اتباع القاتل بالمعروف، من غير أن يشق عليه، ويحمله ما لا يطيق من الدية، أو يمن عليه بعفوه عنه عن القصاص، أو يؤذيه.
﴿ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾؛ أي: وعلى القاتل إيصال ما اتفق عليه من الدية إلى وارث المقتول.
﴿ بِإِحْسَانٍ ﴾ الباء للمصاحبة؛ أي حال كون هذا الأداء مصحوبًا بالإحسان الفعلي، بأداء ما اتفق عليه من الدية وافيًا، من غير مماطلة، أو مضارة، ومصحوبًا بالإحسان القولي بشكره والدعاء له، مقابل عفوه عن القصاص منه، واتباعه له بالمعروف.
﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ الإشارة إلى المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾، وهو مشروعية العفو عن القصاص إلى الدية؛ أي: شرعنا لكم العفو عن القصاص إلى الدية تخفيفًا من ربكم عليكم، وقد كان الحال عند اليهود تحتُّم القصاص، وعند النصارى تحتم العفو، وليس لهم أخذ الدية، فخير الله عز وجل هذه الأمة بين الأمور الثلاثة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ »[4].
وقوله: ﴿ من ربكم ﴾؛ أي: من خالقكم ومالككم ومدبِّركم، والخطاب لجميع المؤمنين، وأضاف اسمه عز وجل «الرب» إلى ضميرهم تذكيرًا لهم بنعمة ربوبيته لهم ليشكروه.
﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾؛ أي: ورحمة من ربكم أيها المؤمنون، فمشروعية القصاص رحمة من الله عز وجل بجميع المؤمنين، وإسقاط القتل عن القاتل بالعفو رحمة له، وإباحة الدية لورثة المقتول رحمة لهم.
﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية، أي: فمن اعتدى من أولياء المقتول، فقتل القاتل بعد العفو عن القصاص، وقبول الدية، أو بعد العفو مطلقًا.
ويحتمل أن المراد: فمن اعتدى من أولياء المقتول، أو القاتل الذي عفي عن القصاص منه فعاد إلى القتل مرة أخرى.
﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ جملة جواب الشرط؛ أي: ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة، مع ما يترتب عليه في الدنيا من العقوبة بالقصاص أو غيره.
و﴿ أليم على وزن «فعيل» بمعنى «مفعل»؛ أي: مؤلم حسيًّا للبدن، ومعنويًّا للقلب.
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أُصيب بقتل أو خَبْلٍ، فإن أراد يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك، فله نار جهنم خالدًا فيها»[5].
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أُعفي رجلًا قتل بعد أخذ الدية - يعني لا أقبل منه الدية، بل أقتله»[6].
وإنما شدَّد القرآن في أمر من يعفو عن القصاص، ثم يعتدي بعد ذلك على القاتل فيقتله؛ لما فيه من الخيانة، وعدم الوفاء بالعهد، ولما فيه من الشبه بمن يعود في هبته.
قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾.
قوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ﴾، أي: ولكم في شرع القصاص، وهو قتل القاتل بمن قتله، على الصفة التي قتله عليها، وفي قوله: «لكم» إشارة إلى أن القصاص إنما شرع رحمة لكم، وإحسانًا إليكم، وهكذا كل ما شرعه الله، إنما شرعه رحمة بالعباد، وإحسانًا إليهم، ولذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].
﴿ حياة ﴾ نكِّرت للتعظيم والتكثير، أي: حياة عظيمة كثيرة للنفوس ببقائها وسلامتها من القتل وصونها وحقن الدماء؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيُقتل قصاصًا، أو توقَّع ذلك، كفَّ عن القتل، وارتدع خوفًا على نفسه، فكان في ذلك حياة له، ولمن أراد قتله، وللعنصر الإنساني.
قال ابن القيم[7]: «قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[البقرة: 179]، وهذا أحسن من قولهم: «القتل أنفى للقتل» لوجوه سبعة:
الأول: أن قولهم: «القتل أنفى للقتل» في ظاهره متناقض؛ لأنه جعل حقيقة الشيء منافية لنفسه، وإن قيل: إن المراد منه أن كل واحد من أفراد هذا النوع ينفي غيره، فهو أيضًا ليس أنفى للقتل قصاصًا، بل أدعى له، وإنما يصلح إذا خصص، فقيل: القتل قصاصًا أنفى للقتل، فيصير كلامًا طويلًا، مع أن التقييدات بأسرها حاصلة في الآية.
الثاني: أن القتل قصاصًا لا ينفي القتل ظلمًا؛ من حيث إنه قتل، بل من حيث إنه قصاص، وهذه الجملة غير معتبرة في كلامهم.
الثالث: أن حصول الحياة هو المقصود الأصلي، ونفي القتل إنما يراد لحصول الحياة، والتنصيص على الغرض الأصلي أولى من التنصيص على غيره.
الرابع: أن التكرار عيب، وهو موجود في كلامهم دون الآية.
الخامس: أن حروف «في القصاص حياة» اثنا عشر، وحروف «القتل أنفى للقتل» أربعة عشر.
السادس: أنه ليس في كلامهم كلمة يجمع فيها حرفان متلاصقان متحركان إلا في موضع واحد، بل ليس فيها الأسباب حقيقة متوالية، وقد عرف أن ذلك مما ينقص من سلاسة الكلام بخلاف الآية.
السابع: أن الدافع لصدور القتل عن الإنسان كراهته لذلك، وصارفه القوي عنه، حتى إنه ربما يعلم أنه لو قتَل قُتل، ثم لا يرتدع، وإنما رادعه القوي هو إما الطمع في الثواب أو الذكر الجميل، وإذا كان كذلك فليس أنفى الأسباب للقتل هو القتل، بل الأنفى لذلك هو الصارف القوي».
فيا لها من حكمة عظيمة في مشروعية القصاص، فيها صون النفوس المعصومة وبقاؤها، وأمن الناس على دمائهم.
وما تسلَّط المجرمون وعصابات السطو والقتل والإجرام، إلا بعد أن عطل حكم القصاص في كثير من بقاع الأرض، بما في ذلك كثير من البلاد الإسلامية بذريعة الرحمة والإنسانية المزعومة، وأن القتل همجية، حتى غصت السجون بالمجرمين، فيا سبحان الله، كيف يرحم المجرم، ولا يرحم المجتمع كله من شره، إنه انتكاس القلوب والفطر، وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].
قوله: ﴿ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾؛ أي: يا أصحاب العقول النيرة التي تتعقل وتتدبر أحكام الله عز وجل، وما فيها من الحكم والمصالح، وتهدي أصحابها إلى ما ينفعهم، وتحجزهم عما يضرهم، ولهذا خصَّهم الله عز وجل دون غيرهم ممن لا يعقل.
وفي هذا ثناء منه عز وجل عليهم، وامتداح لهم؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 17، 18].
﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ الجملة تعليلية، أي: لأجل أن تتقوا الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، والتي من أعظمها قتل النفوس المعصومة بغير حق.
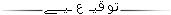
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|