 الشخصية المحمدية بين البشرية والنبوة
الشخصية المحمدية بين البشرية والنبوة


الحمد لله الذي أرسل رسولَه بالهُدى ودينِ الحقِّ؛ لِيُظْهِرَه على الدين كلِّه ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه وسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:
فقد مَنَّ اللهُ تعالى على خلقِه أجمعين، بأنْ أرسلَ رسولَه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالَمِين، واصطفى له أسْمَى الصِّفات البشرية، وهداه صِراطَه المستقيم، وحَلَّاه بالخُلُقِ العظيم، فلا أحدَ أهدى منه سبيلًا، ولا أصدقَ منه لسانًا، ولا أفصحَ منه بيانًا، ولا أطهرَ منه نَفْسًا، ولا أتقى منه قلبًا، ولا أعدلَ منه حُكمًا، ولا أكرمَ منه خُلُقًا، ولا أطهرَ منه سَجِيَّة، ولا أكرمَ منه عطاءً، ولا أحسنَ منه بلاءً.
ولم يجعلْه اللهُ مَلَكًا رسولًا، ولكن عبدًا رسولًا، يأكلُ الطعام، ويمشي في الأسواق، ويتزوَّج النساء، ويفرح كما يفرح الناس، ويضحك كما يضحكون، ويحزن كما يحزنون، ويبكي كما يبكون، له كامِلُ الصِّفات البشرية، في أتمِّ صورة.
وجَسَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكمالَ في صورته البشرية، سواء قبل البعثة أم بعدها، فقد عَصَمَه الله تعالى من الشيطان وهو صغير؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ [أي: أنامَه على ظَهْرِه]، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً [أي: قِطْعَةً يَسِيرةً من دَمٍ مُتَجَمِّد]، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ.
ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ [أي: جَمَعَه، وضَمَّ بَعْضَه إلى بعض]، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ، يَعْنِي ظِئْرَهُ [أي: مُرضِعَتَه]، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ [أي: مُتَغَيِّر اللَّون]»، قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ»؛ رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: (وَكَانَ هَذَا فِي زَمَنِ الطُّفُولِيَّةِ، فَنَشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ).
فهذه الحادِثَةُ تُبَيِّن لنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مُتمَتِّعًا بخصائص البشرية، وكان يجد في نفسِه ما يجد، من مختلف المُيول الفِطرية، التي اقتضت حِكمةُ الله أن يُجبل الناسُ عليها، لكنَّ الله تعالى عَصَمَه من جميع مظاهر الانحراف، وعن كُلِّ ما لا يَتَّفِق مع مقتضيات الرِّسالة التي هيَّأَهُ لها، وما زال صلى الله عليه وسلم يتدرَّج في درجات الكمال البشري حتى بَلَغَ ذِروَتَه، وصَعَدَ سنامَه في سِنِّ الأربعين.
ففي هذا العصر الذي انتشرت فيه عِبادةُ الأوثان، وشُرْبُ الخمر، وسائر المحرَّمات، ينشأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب الخمرَ، ولم يأكل مما ذُبِحَ على النُّصب، ولم يحضر للأوثان عِيدًا ولا احتفالًا، وكان نافِرًا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيءٌ أبغض إليه منها، وحتى كان لا يستطيع أن يصبر على سماع الحَلِف باللَّات والعُزَّى.
وأما من حيث سلوكه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الكمالَ في السلوك القويم، والخُلُق الكريم، فكان أحسنَ الناس خلقًا، وأعزَّهم جِوارًا، وأعظمَهم حلمًا، وأصدَقَهم حديثًا، وألْيَنَهم عريكة، وأعَفَّهم نفسًا، وأكرمَهم خيرًا، وأبَرَّهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، حتى سمَّاه قومُه: "الأمين"، وقد قالت له أمُّ المؤمنين خديجةُ رضي الله عنها - في لحظةٍ صعبة من حياته المباركة -: «وَاللَّهِ، مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»؛ رواه البخاري ومسلم.
كلُّ هذه الصِّفات وغيرُها جعلته صلى الله عليه وسلم يتبوأ منزلةً ومكانةً في قومه، فقصَدَه الناسُ؛ لِيُودِعُوا عنده أماناتهم، وارتضوا بِحُكمه في شؤونهم، وليس أصدق مثالًا على ذلك من قِصَّةِ وَضْعِ الحجر الأسود في مكانه من الكعبة.
وكان هذا البناء، وذلك الإعداد الرَّباني للشخصية المحمدية - قبل البعثة - لِيَتَحَمَّلَ أعباءَ الرسالة، وعِظَمَ المسؤولية في التبليغ عن ربِّه ما أُرسِل به.
ثم جاءت اللَّحظة الفارِقة، والسَّاعة الحاسِمة في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيَنْتَقِلَ من هذا الكمال البشري، إلى نوعٍ آخرَ من الكمال، لا يصل إليه إلَّا المُصْطَفَونَ الأخيار من أنبياء الله ورسله، إنه الكمالُ الخاصُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنه كمال النُّبوة.
ففي ليلةٍ من أعظم ليالي البشرية، وفي لحظةٍ من أسمى لحظات الإنسانية؛ تَتَّصِلُ السماءُ بالأرض، ويُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويُدْعَى؛ بل ويُؤمَر بالتبليغ عن ربِّ العزة تبارك وتعالى ما أوحاه إليه من القرآن والسُّنَّة.
وكان لازِمًا - للقيام بهذه المُهِمَّة، وأداءِ هذه الأمانة - أنْ يَصِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى درجةٍ أعلى من الكمال، فكان تعليمُ اللهِ له ما لم يكن يعلم، وكانت الحِكمة النبوية، قال تعالى لنبيِّه الكريم صلى الله عليه وسلم في مقام المَنِّ والتَّذكير بأعظمِ نِعمةٍ عليه: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: 113]، فكان هذا الفيض الإلهي المُباشر إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيَكُون سَيِّدَ هذه الأُمَّة بِلا منازع؛ بل سَيِّدَ ولد آدم بِلا مُنافس.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على النبيِّ المصطفى، أمَّا بعد:
عباد الله، إنَّ النبوة المحمدية هي أعلى درجات الكمال، والتي فَطِنَ لها عمُّه العباسُ رضي الله عنه في فتح مَكَّةَ، عندما رأى أبو سفيان كَتائِبَ الحقِّ، وجنودَ الله تترى، فقال: (لقد أصبحَ مُلْكُ ابنِ أخيك عَظِيمًا)، فقال له العباسُ رضي الله عنه: (إنها النبوة).
نعم - أيها المؤمنون - إنها النبوة التي أعَدَّه اللهُ لها، في صورته البشرية قبلَ البعثة، والتي قطف العالَمُ ثِمارَها بعدَ البعثة، في تلك الرسالة، وهذا الدِّين العظيم؛ لِيُصْبِحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعظمَ شَخْصٍ في التاريخ.
ولِيُصْبِحَ النموذجَ الأعظمَ المُعَبِّر عن الكمال في صورته البشرية؛ سواء قبل النبوة أم بعدها، ولِيتَبَارى الكُتَّابُ والمُؤلِّفون للكتابةِ عنه صلى الله عليه وسلم، من كُلِّ صوب وحدب، على اختلاف أديانِهم وتَنَوُّع مذاهبِهم، وكُلُّهم مُجْمِعون على عظمة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وشَخْصِه الكريم، بأبي هو وأُمِّي.
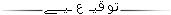
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|