 لا تزكوا أنفسكم
لا تزكوا أنفسكم


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أيها المسلمون، إن الإنسان مخلوق ضعيف مهما ملك من أسباب القوة، ومخلوق عاجز ولو نال ما نال من وسائل القدرة، وهو ذو جهل كبير وإن علم ما شاء من العلوم، وبرع في حسن التصوُّرات والفهوم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 85].
والإنسان مليء بالعيوب والعثرات، والنقائص والهفوات، فلا يليق به وهذه حاله أن يرى لنفسه السلامة من نقص وعيب، وأن يبدو بالفخر والعُجْب.
قيل: إن "قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تُحصَى، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب، ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها، قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان"[1].
وقد صدق الشاعر حين قال:
يَا مَنْ يَعِيْبُ وَعَيْبُهُ مُتَشعِّبٌ
كَمْ فِيْكَ مِنْ عَيْبٍ وأنْتَ تَعِيْبُ!
للهِ دَرُّكَ عَائِبًا مُتَسَرِّعًا
أيَعِيبُ مَنْ هُوَ بِالْعُيوبِ مَعِيْبُ؟![2]
وقال الآخر:
هل في ابْنِ آدمَ غيرُ الرَّأسِ مَكْرُمةٌ
وهْو بِخَمْسٍ مِنَ الآفاتِ مَضْروبُ
أنْفٌ يَسيلُ وأذْنٌ ريحُها سَهِكٌ
والعَيْنُ مُرْمَصَةٌ والثَّغْرُ مَلْعوبُ
يا بْنَ التُّرابِ ومأكولَ التُّرابِ غَدًا
أقْصِرْ فإنَّك مأكولٌ ومَشْروبُ[3]
أيها المؤمنون، والإنسان كذلك يُحِبُّ الثناء على نفسه، والتحدُّث عن فضائله، ومدح غيره له، ويرى أنه أحسن من سواه في مواهبه وقُدْراته، وأعماله وصفاته، وأنه قد خلا من العيوب، أو أنها قليلة فيه، كما قال المتنبي عن نفسه:
كم تطلبونَ لنا عَيبًا فَيُعْجِزُكُمْ
وَاللَّهُ يَكْرَهُ مَا تَأْتُوْنَ وَالكَرَمُ
ما أَبعد العيبَ والنقصانَ عَنْ شَرَفِي
أَنَا الثُّرَيَّا وَذَانِ الشَّيْبُ وَالهرمُ!
"قيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه"[4].
ومتى وصل المرء إلى هذه الحال، فهذا من جهله بشخصه، وقلة معرفته بحاله؛ إذ لو فتش العاقل في عيوبه لما أثنى على نفسه، ولا رأى لها الرقي على غيره، ولا وجد ما يدعوه إلى تعييب سواه والهزء به.
والإنسان حين يشعر بالفضل على الناس-وليس له زكاء يردعه-فإنه يحسد الآخرين المنافسين له في ذلك الفضل أو المتقدِّمين عليه فيه، فيحمله ذلك على نفخ النفس، والاعتداد بالذات، وإظهار العلوِّ على غيره من الناس، والطعن في فضائلهم والتحقير من شأنهم، وهذا كُله من ضلال الرأي، وظلام البصيرة، ودنوِّ الشأن، وشحة الفضائل، وغلبة الهوى، وفقر النفس.
أمَا إننا- معشر المسلمين- لو قرأنا القرآن وتدبَّرناه، وعملنا به واتبعناه؛ لزال هذا الغبش عن النفس، وانقشع هذا الغبار أمام ضياء الروح حتى يشرق نورها على حياة صاحبها، يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: 49]، وقال سبحانه: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32].
قال المفسرون: والمعنى: فلا تمدحوها على سبيل الفخر والإعجاب، ولا تنسبوها إلى زكاء الأعمال والطهارة عن المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها، ولا تحسبوا أنفسكم أزكياء؛ بل ابتغوا زيادة التقرُّب إلى الله، ولا تثقوا بأنكم زاكون؛ فيدخلكم العجب بأعمالكم، ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخُر بها، أو إظهارها للناس.
وإيَّاكم أن تقولوا لمن لم تعرفوا: أنا خير منك، أو أنا أزكى أو أتقى؛ فإن العلم عند الله، واحذروا أن تخبروا بزكاة أنفسكم وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون؛ ولهذا قال عقيب ذلك: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32]؛ أي: بمن اتقى منكم وبمن فجر، فلا حاجة إلى ذكر ذلك منكم؛ فقد علم الله منكم الزكي والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم، وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم، وفيه إشارة إلى وجوب خوف العاقبة؛ فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى[5].
عباد الله، إن المسلم مأمور بالتواضع للخَلْق، وترك الكبر عليهم؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: 88]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: 37]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ))[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ))[7].
والمسلم مدعوٌّ إذا عمل عملًا صالحًا مستحبًّا، وكان له سبق إلى البر وخبيئة من الخير؛ ألَّا يُظهِر ذلك للناس إن أمكن إخفاؤه؛ ليكون ذلك أدعى إلى الإخلاص والقبول والاستمرار، وأبعد عن الرياء والعجب والحبوط والانقطاع.
قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ))[8]، وهذا كان دأْبُ الصالحين من السالفين؛ فعَنِ الْحَسَنِ البصري قَالَ: "إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَجْلِسُ الْمَجْلِسَ فَتَجِيئُهُ عَبْرَتُهُ فَيَرُدُّهَا، فَإِذَا خَشِيَ أَنْ تَسْبِقَهُ قَامَ"[9]، وعن محمد بن واسع قال: "إن كان الرجل ليبكي عشرين سنةً وامرأته معه لا تعلم"[10]، وعن إبراهيم النخعي قال: "كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده"[11].
أيها الإخوة الفضلاء، إن المسلم حين ينأى عن تزكية نفسه بمدحها والثناء عليها، والفخر بمزاياها، والرِّضا عنها، واستصغار غيرها بالنظرة الدونيَّة إليهم، ويبعدها عن التكبُّر على الآخرين، وحسد الأقران المنافسين؛ فإنه بذلك يصفو عمله من شوائب الإحباط، وتزكو نفسه من الغرور والإعجاب، ويستمر في الصعود على سلم الترقِّي والصفاء، والاستمرار على الخير والعطاء، ويتربَّع حُبُّه وإجلاله على قلوب الناس، فتثني عليه ألسنتُهم، وتبتهج برؤيته عيونُهم، ويعلو شأنه عندهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ))[12]، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما مِنْ آدَمِيٍّ إلا في رأْسِه حَكَمَةٌ بيد مَلَكٍ، فإذا تَواضَع قيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، وإذا تكَبَّر قيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حَكَمَتهُ))[13][14].
وأحْسَنَ مَنْ قال:
تواضَعْ إذا ما نلتَ في الناسِ رِفْعةً
فإنَّ رفيعَ القومِ مَنْ يتواضَعُ
ولا تتَّصِفْ بالكِبْرِ والعُجْبِ في الورى
فشرُّهما في النفسِ والخَلْقِ واسعُ
وأمَّا إذا نظر الإنسان إلى نفسه بعين الإعجاب، وإلى غيره بعين الاحتقار، فصار معجبًا بعمله الصالح، مرائيًا به، محتقرًا لمن لم يصل إلى ما وصل إليه؛ فهذا العمل مآله إلى الخسران، فعَنْ جُنْدَبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَ ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ! فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ))[15].
وصاحب هذا الخُلُق الرديء يصير مبغوضًا لدى الخلق، دنيَّ المكانة في قلوبهم، مكروهَ البقاء في مجالسهم.
فيا أيها المسلم، اعرف قدر نفسك وحقيقتها، وقصورها وكثرة عيوبها، واعترف لنفسك بضعفها وعجزها، وجهلها ونقصها، وإياك واحتقار الآخرين وازدراءهم، والتباهي عليهم وانتقاصهم؛ بل احترم الناس واعرف أقدارهم، واحملهم على أحسن المحامل، وظُنَّ بهم خير الظنون، واحذر أن تنزل الناس في نفسك علوًّا أو دنوًّا بما ترى من هيئاتهم وصورهم، وما تعرف من فقرهم وغناهم.
فلا تجعل الميزان بالصور والشهادات، والأحوال والهيئات، فأكْرَمُ الناس في الدين ذوو التقوى، وأحسن الناس في تصور ذوي العقول هم أهل العلم النافع والأدب والأخلاق الحميدة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: ((أَتْقَاهُمْ)).
قال الشاعر:
تَرى الرَّجُلَ النَّحيفَ فَتَزْدَريهِ
وفي أثْوابِهِ أسَدٌ هَصورُ
ويُعْجِبُك الطَّريرُ فتَبْتَليهِ
فَيُخْلِفُ ظنَّكَ الرَّجُلُ الطَّريرُ
فما عِظَمُ الرِّجالِ لَهُمْ بِزَيْنٍ
ولكِنْ زَيْنُهُمْ كَرَمٌ وخِيْرُ[16]
لما استخلف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قدم عليه وفود أهل كل بلد، فتقدم إليه وفد أهل الحجاز، فاشرأبَّ منهم غلام للكلام، فقال عمر: يا غلام، ليتكلَّم مَن هو أسنُّ منك! فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصْغَرَيْه: قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبده لسانًا لافظًا، وقلبًا حافظًا، فقد أجاد له الاختيار، ولو أن الأمور بالسِّنِّ لكان هاهنا من هو أحقُّ بمجلسك منك، فقال عمر: صدقت، تكَلَّم؛ فهذا السحر الحلال، فقال: يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المَرْزِئة، ولم تُقَدِّمْنا إليك رغبةٌ ولا رهبةٌ؛ لأنَّا قد أمِنَّا في أيامك ما خِفنا، وأدركنا ما طلبنا، فسأل عمر عن سنِّ الغلام، فقيل: عشر سنين[17].
نسأل الله تعالى أن يصلح أنفسنا، ويُطهِّر قلوبنا، ويعمر بالحق ألسنتنا، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أيها المسلمون، قد يقول قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32]، وقوله سبحانه: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]؟ وهل معنى ترك تزكية النفس: المنع من أن يذكر الإنسان محاسن نفسه لغيره؟
والجواب عن ذلك: أنه ليس هناك تعارض في الحقيقة بين الآيتين؛ فالآية التي تنهى عن تزكية النفس مرادها: النهي عن الاطمئنان إلى النفس ومدحها والثناء عليها، وظنها أنها صالحة لا تحتاج إلى تطهير وتزكية، وأمَّا الآية التي تبين فلاح المتزكِّي فمرادها: الحَثُّ على تزكية النفس من الأخلاق الذميمة، وتطهيرها من الأعمال والأقوال السيئة؛ حتى تكون نقيَّة صافية فيحصل لها الفلاح.
معشر المسلمين، وأمَّا ذكر الإنسان محاسن نفسه وفضائله، فإن المذموم من ذلك ما كان على الطريقة التي قدمنا الحديث عنها في الخطبة الأولى.
وأمَّا إذا كان هناك غرض صحيح للحديث عن ذلك؛ من أجل مصلحة مشروعة-دينية أو دنيوية- من غير أن يصحب الحديثَ كِبْرٌ للنفس واحتقار لسواها؛ فذلك أمر مشروع بقدر الحاجة إليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن ذكر الإنسان محاسن نفسه ضربان: مذموم ومحبوب، فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميُّز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرًا بمعروف، أو ناهيًا عن منكر، أو ناصحًا أو مشيرًا بمصلحة، أو معلمًا، أو مؤدبًا، أو واعظًا، أو مذكِّرًا، أو مصلحًا بين اثنين، أو يدفع عن نفسه شرًّا، أو نحو ذلك، فيذكر محاسنه ناويًا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله، واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به، أو نحو ذلك، وقد جاء في هذا المعنى ما لا يُحصى من النصوص"[18].
قال الله تعالى: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 55]، قال بعض العلماء: "فإن قيل: كيف مدح نفسه بهذا القول، ومن شأن الأنبياء والصالحين التواضُع؟
فالجواب: أنه لما خلا مَدْحُه لنفسه من بغيٍ وتكبُّرٍ، وكان مراده به الوصول إِلى حق يقيمه وعدل يُحييه، وجور يبطله، كان ذلك جميلًا جائزًا.
وقال علي بن أبي طالب: "والله، ما من آية إِلا وأنا أعلم أبِليل نزلت، أم بنهار"، وقال ابن مسعود: "لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإِبل لأتيته، فهذه الأشياء خرجت مخرج الشكر لله، وتعريف المستفيد ما عند المفيد"[19].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا))[20]، وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: "وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِن الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ - وهم طائفة من أهل الكوفة-تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي، وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي"[21].
نسأل الله أن يُصلِح نفوسنا، ويغفر ذنوبنا، ويذهب فساد قلوبنا، هذا، وصلُّوا وسلِّمُوا على البشير النذير.
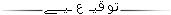
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|