 الهجرة النبوية الشريفة: دروس وفوائد ولطائف
الهجرة النبوية الشريفة: دروس وفوائد ولطائف


إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده اللهُ فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يقول صلوات الله عليه: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»[1].
أخا الإسلام:
تَاللَّهِ لَوْ عَاشَ الْفَتَى فِي أَهْلِهِ
أَلْفًا مِنَ الْأَعْوَامِ مَالِكَ أَمْرِهِ
مُتَلَذِّذًا مَعَهُمْ بِكُلِّ لَذِيذَةٍ
مُتَنَعِّمًا بِالْعَيْشِ مُدَّةَ عُمْرِهِ
لَا يَعْتَرِيهِ النَّقْصُ فِي أَحْوَالِهِ
كَلَّا وَلَا تَجْرِي الْهُمُومُ بفكرهِ
مَا كَانَ هذا كُلُّهُ في أن يَفِي
بِمبيت أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي قَبْرِهِ
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا رسول الله، لما دخل المدينة المنورة ألقى بيانًا جامعًا مانعًا شافيًا حازمًا حاسمًا يُسطَّر كميثاق بين الأمم، تفوح منه رائحة الحبِّ والود، قال فيه: «أَيها الناسُ، أَفْشُوا السلامَ، وأَطْعِمُوا الطعامَ، وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجنةَ بسَلَامٍ»[2].
لو أنَّ إنسانًا تخير ملةً
ما اختار إلا دينكَ الفقراءُ
الْمُصلِحونَ أَصابِعٌ جُمِعَت يَدًا
هِيَ أَنتَ بَل أَنتَ اليَدُ البَيضاءُ
أنصفتَ أهلَ الفقر من أهل الغنى
فالكلُّ في حقِّ الحياة سواءُ
أما بعد: إخوة الإيمان، إنه لم تحفل سيرة بشر منذ عهد أبينا آدم عليه السلام بالعناية والاهتمام وشديد المتابعة والتحري والتدقيق والتدوين، كما لقِيته سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك، فهو سيد البشر أجمعين وحبيب رب العالمين، وخير الخلق أجمعين، ومما اعتنى به المسلمون غاية العناية حدث هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة البلد الحرام إلى طيبة إلى مدينة الأنصار[3]، ولا شك أن حدث هجرته صلى الله عليه وسلم حافل بالعبر والدروس، مليءٌ بالأحداث الكبار والأخبار العظام، التي غيرت مجرى التاريخ البشري وحولت وجهه، وأشرقت الأرض بنورها ضياء وابتهاجًا، ولا شك أن من الواجب علينا، والأمة الإسلامية تمر في محنٍ عصيبة أن نقف مع سيرة رسول الله ومع الهجرة النبوية، لعلنا نستقي منها الدروس والعبر، ولست هنا بصدد الحديث عن أحداث ومجريات الهجرة المباركة، فالوقت لا يسعفنا لكل ذلك، ولكنني بمشيئة الله سأقف عند بعض العبر والدروس التي تؤخذ من أحداث الهجرة، ثم نجعل من دروسها واقعًا نستفيد منه لحياتنا التطبيقية، نجعل منها درسًا نستفيد منه لحل مشاكلنا ومعضلاتنا التي تتراكم في حياتنا اليوم.
واسمحوا لي أن أعيش معكم اليوم مع عبرتين اثنتين - من عبر الهجرة النبوية - لا أزيد عليهما[4]: العبرة الأولى: هي أن كل مَنْ عَبَد المال والمنصب، فلا بدَّ أن يكون شقاؤه وذله وهلاكه على يد هذا المال، وكل من استخدم المال خادمًا ذليلًا مَهِينًا لمرضاة الله عز وجل؛ لا بدَّ أن يتحوَّل المال في حياته إلى سُلَّمٍ يرقى به إلى أعلى درجات العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والقوة بعد الضعف، هذه هي العبرة الأولى، وإنكم لتلاحظون ذلك في معنى ترك أصحاب رسول الله، بل رسول الله ذاته: (الوطن والأرض والمال وربما الأهل)؛ لحاقًا بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، لحاقًا بتنفيذ أمر الله وكأن أحدهم يتجه إلى شطر المدينة المنورة وهو يقول لربه: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: 84]، فماذا كانت النتيجة؟!
كانت النتيجة أن تحوَّل المال الذي استخدموه لمرضاة الله والذي أعرضوا عنه - بكل معنى الكلمة - في سبيل أن يستعيضوا عن المال رضا الله عز وجل، كانت النتيجة أن قَدَّم الله لهم من المال سُلَّمًا أمام أقدامهم، ارتقوا بهذا السُّلَّم إلى أعلى درجات الغنى، وإلى أعلى درجات القوة، وإلى أعلى درجات الوحدة والترابط.
مع أن الفراق في بادئ الأمر وظاهره كان صعبًا وأليمًا على رسول الله، فمكة - فضلًا عن كونها مولدًا ومنشأً للرسول وأصحابه - فهي كذلك مهوى للأفئدة، بل هي مغناطيس القلوب، ففيها الكعبة البيت الحرام الذي جرى حبُّه منهم مجرى الروح والدم، ولكنَّ شيئًا من ذلك لم يمنعه وأصحابه من مغادرة الوطن، ومفارقة الأهل والسكن، حين ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة، وتنكَّر أهلها لهما.
وقد تجلَّت هذه العاطفة المزدوجة - عاطفة الحنين الإنساني وعاطفة الحب الإيماني - في كلمته التي قالها مخاطبًا مكَّة في وداعها: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحبَّكِ إلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ»، فطمأَنه ربه بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: 85]، ستعود إليها يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن وأنزله على قلبك، هو الذي سيردُّك إلى مكة، وانظروا إلى اختيار لفظ التطمين لرسول الله: ﴿ لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ ﴾، لماذا لَرَادُّكَ بهذا التعبير بالذات؟! كأنَّ الله يريد أن يذكِّر رسوله بقوله لأم موسى: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: 7]، فكما رددتُ موسى إلى أمِّه، سأردُّك يا محمد منتصرًا مكرمًا: ﴿ إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ... ﴾[5].
إذًا الفراق في بادئ الأمر وظاهره كان صعبًا وأليمًا على رسول الله، لكن النتيجة كانت سببًا لنهضة الإسلام وانتشاره وتوطده، وهكذا فرُبَّ ضارَّة نافعة، بل كم من مِحنةٍ محويَّة في طيِّها مِنَحٌ ورحماتٌ مطويَّة، وهذه المحن الأليمة العصيبة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم لها ظاهر وباطن، أما الظاهر الجلي فمأساة تتقطع لها القلوب، محنة ما أظن أن تاريخنا الإسلامي بحلوه ومره سجل مثل هذه الظاهرة الأليمة، هذا هو الظاهر محنةٌ وبلاء، وأما الباطن فإنما هو منحةٌ من منح الله عز وجل؛ ليستبين الصادق من الكاذب، ولكي تتمزَّق أقنعة النفاق، فيعرف المؤمن الصادق من غيره: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: 2، 3].
أما الدرس الثاني الذي ينبغي أن نقطف منه العبرة، لا لنحفظه بل لنطبقه، فهو أن الله عز وجل يكلف عباده المؤمنين أن يعتمدوا في سلوكهم وفي أعمالهم على الأسباب المادية العادية التي وضعها بين أيديهم، كلَّفهم الله عز وجل ألا يدخروا وسعًا لاستخدام هذه الأسباب، ولكن عليهم مع ذلك وبعد ذلك ألا يجعلوا معتمَدهم إلا على توفيق الله عز وجل ونصره، وألا يلجؤوا بقلوبهم وبثقة أفئدتهم وبعقولهم إلا إلى نصر الله سبحانه وتعالى وتأييده، وإنكم لتعلمون أن رسول الله في هجرته لم يدخر وسعًا في تجنيد كل الوسائل المادية التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين يديه لإنجاح عمله مهاجرًا من مكة إلى المدينة، فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب الكاملة في هجرته، وكأنها كل شيء، لم يدع النبي مكانًا للحظوظ، فما من ثغرة إلا وقد غطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، هيأ رجلًا يأتيه بالأخبار، وهيأ رجلًا يمحو الآثار، وهيأ من يأتيه بالطعام والشراب، وهيأ خطةً تبعد عنه الشبه اتجه جنوب مكة، واستقر في غار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنه، وهيأ دليلًا غلب فيه الخبرة على الولاء ولم يدع ثغرةً إلا وغطاها، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، فلما وصلوا إليه وأصبح أحدهم على بعد أمتار منه، وقال الصديق رضي الله عنه لرسول صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا"، الآن لأنه أخذ بالأسباب طاعةً وأخذ بالأسباب تعبدًا، ولم يعتمد على الأسباب كما يفعل أهل الغرب، قال الرسول لأبي بكر مطمئنًا له: "يا أبا بكر، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا"، ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 40]، وهكذا عناية الله تكون بعد أن يستنفذ العبد كل الأسباب التي جعلها الله بين يديه، فإذا انقطعت ولم تكن فاعلة، وجد العبدُ النصر الإلهي، لذلك قال الله تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم ﴾ [محمد:7]؛ أي: إن نصره سبحانه للمؤمنين مرهون بأمرين[6]:
1- الإعداد المادي والمعنوي لاستحقاق النصر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60].
2- نصرة دين الله بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه، وأن تقف مع الحق، وتحكم بالعدل، ولا تأخذك في الله لومة لائم، إن فعلت ذلك فقد نصرت دينه، وسينصرك الله سبحانه.
أما الاتكال على مجرد الاتصاف بالإسلام قولًا لا عملًا، وأن نطلب النصر دون إعداد ودون عمل بالأسباب، فكل ذلك لا يحقق شيئًا من النصر المرتجى على أعداء الله.
ولعل هذا الدرس من أهم الدروس التي نستفيدها من هجرته صلى الله عليه وسلم "أن نأخذ دائمًا بالأسباب، وكأنها كلُّ شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.."، فعند ذلك يكون التوفيق والمدد والنصر.
أيها الأحبة، دروس وعبر الهجرة كثيرة وكثيرة، نحتاج للوقوف عليها إلى خطب عديدة، نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا دائمًا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفروا الله[7].
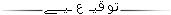
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|