 غزوة بدر الكبرى
غزوة بدر الكبرى


صباح الجمعة الموافق لليوم السابع عشر من رمضان، سنة (2هـ)
الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، سنة من سنن الحياة على هذه الدار، والقوة عنصر رئيس في إدارة هذا الصراع وإدالته، ولا تتكافأ المبادئ ولا يحتدم الصراع، ولا يكون الظهور سجالًا بين الأطراف المتباينة إلا بوجود ذلك العامل: القوة، وتلك القوة قوة حجة وبيان، وقوة مواجهة.
ولا شك أن الحق لا يفتقر إلى القوة الأولى، بل براهين أحقيته واضحة، ولكن قد تنقصه القوة الثانية في بعض الأزمنة والأمكنة، ومن غير اجتماع القوتين لا يمكن أن يسود وينتشر انتشارًا كبيرًا، فلهذا شرع الله تعالى لأنبيائه جهاد أعداء دينه الذي يقفون في طريق نشره، ويصدون الناس عن قبوله، فصارت هذه الشعيرة شرعًا متفقًا عليه بين الشرائع السماوية كافة؛ لأن الفكرة إذا لم يكن لها قوة تحميها وتبلغها، فلن يُكتَب لها البقاء والذيوعُ، غير أن هذه الشعيرة العادلة قد يتوقف العمل بها في بعض الأوقات والأماكن لعدم وجود الأحوال المناسبة التي توصل إلى غاياتها المنشودة التي شُرعت لأجلها، كما كان عليه الحال في العهد المكي؛ إذ لم يكن لدى المسلمين آنذاك ما يستطيعون به الصمود في المواجهة العسكرية، ولكن لما تحوَّل المسلمون إلى المدينة، وصار لهم دار ومأوى وعدد وعدة، بدأت الآيات الحاثة على الجهاد تتنزل تباعًا، وما زالت كذلك حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا.
الطريق إلى بدر:
إن وصول مواكب المهاجرين إلى المدينة، واجتماعهم مع الأنصار على تكوين قوة جديدة لها عقيدتها المخالفة لما عليه الناس في ذلك الزمن، عقيدة تحكم على ما سواها بالبطلان، وتدعو الناس إلى الانضمام إليها وتركهم أديانَهم السابقة، وتقوم بتغيير جذري في الحياة؛ إن ذلك كله لم يكن بالأمر الهيِّن الذي ستسكت عنه قوى الباطل، خاصة القوة القرشية التي كانت لها زعامتها في ذلك الحين، ولا ننسى قبائل اليهود القاطنة مع المسلمين في المدينة التي كانت تبطن الحقد الشديد لهم، إضافة إلى الأعراب المحيطين بالمدينة؛ فلذلك لم يكن بقاء المسلمين في طيبة الطيبة قبل بدر يتسم بالاستقرار الأمني، والاطمئنان من المباغتة من القوى المعادية، ولتلك الحال بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة لا يبيت إلا محروسًا، وكان المسلمون لا يبيتون إلا في سلاحهم كذلك؛ تخوفًا من هجوم عدو مفاجئ.
ولم يكن هاجس الخوف آنذاك خاطرًا عابرًا، بل كان شعورًا سليمًا، فقريش ترسل تهديداتها إلى المدينة عبر عبدالله بن أبي ابن سلول قائلةً: "إنا سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم"، بل بلغ الأمر إلى وصول قوة خفيفة من المشركين بقيادة كرز بن جابر الفهري إلى مراعي المدينة لينهب بعض مواشيها ويعود سالِمًا.
فلما كان الأمر كذلك، صار من الأمور المسلمة اقتراب اللقاء الدامي بين جمع الحق وجمع الباطل، فأنزل الله تعالى الإذن بالقتال مصحوبًا بموجباته في قوله: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: 39]، ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 40].
ومن هنا تجلى للمسلمين أهمية الاستعداد العسكري، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيز السرايا وبعثها إلى تخوم المدينة، فبدأ فعلًا العمل العسكري بين فترة وأخرى، فكان بين يدي بدر غزوات وسرايا متعددة، كان أكثر أهدافها اعتراض قوافل قريش التجارية، والغرض إرسال رسالة إلى قريش مفادها أن عيون المسلمين ساهرة، وأنهم قوة يمكنها المواجهة والمقاتلة.
فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون على ذلك النشاط العسكري عبر تلك السرايا والكتائب، حتى وصل بعضها إلى قرب مكة، فقتلت من المشركين وأسرت وغنمت وعادت سالمة؛ كسرية نخلة التي كان قائدها عبدالله بن جحش رضي الله عنه، وهنا أدرك المشركون أن الخطر الإسلامي عليهم لم يعد وهمًا، بل صار حقيقة.
إن قريشًا لم تكن تكف عن رحلاتها التجارية إلى الشام عبر أطراف المدينة؛ لأن حياتها لا تقوم إلا بذلك، ومع ما سبقت الإشارة إليه من اعتراض المسلمين المتكرر لقوافلهم، إلا أنهم ظلوا ماضين في ذلك الطريق، وفي قافلة من تلك القوافل بلغ المسلمين خبرها خرج رسول الله بجمع من المسلمين في طلبها، لكنهم وصلوا وقد فاتتهم، فعادوا إلى المدينة، فلما بلغهم رجوعها استعدَّ رسول الله بثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا من المسلمين، فخرجوا لاعتراض تلك القافلة، فبلغ خبر خروج المسلمين قائد القافلة أبا سفيان، فغيَّر مسارها، وأرسل النذير إلى قريش، فخرج المشركون من مكة بحدهم وحديدهم وكبرهم وخيلائهم لمواجهة المسلمين بجيش قوامه ألف مقاتل، ولَمَّا بلغ الخبر المسلمين أيقنوا بحصول الجلاد الذي لا مفرَّ منه، فاستعد المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلقوا إلى ساحة المعركة، وأخذوا مراكزهم منتظرين ساعة اللقاء الحاسم.
شروق يوم الفرقان:
صباح الجمعة الموافق لليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة[1] تشرق الشمس على موضع يقال له: بدر، وفيه فئتان متقابلتان: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، اجتمع الفريقان، وفي ذلك الصباح القاني كان اللقاء بين السيوف، بعد أن كان اللقاء بين الحجج ومعارضتها، يلتقي هناك المظلوم الذي عُذِّب وأُهين وأُخرج من داره وأهله، بالظالم المعتدي الذي خرج بطرًا ورياءً يصد عن سبيل الله ويحارب أولياءه، لم يكن ذلك اللقاء لحميَّة أو عصبية قبلية أو قومية، أو أغراض دنيوية، بل كان لقاء بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والخير والشر في معركة فاصلة تحدِّد مسارات التعامل بعدها، فلذلك التقى على حد السنان الأخُ بأخيه، والابن بأبيه، والقريب بقريبه والصاحب بصاحبه، لم تبقَ هناك رابطة غير رابطة العقيدة، وعليها يحارب المخالف، وينصر المؤالف.
ينقدح زناد المعركة بمبارزة سريعة تُلقي بظلالها القاتمة على قلوب الكفار رعبًا وهلعًا، وفي صفوفهم ارتباكًا واضطرابًا، وعلى إثرها بدأ الهجوم العام الذي كان من قِبَل المسلمين كالسيل الجارف الذي يجرف ما أمامه، أو كحال الأسود الجائعة تنقضُّ على فرائسها التي طالما اشتهتْ لقاءها.
فلما دارت حومة الوغى على المشركين، وصارت ظلال سيوف المسلمين غير منقشعة عنهم، ورأت جحافل الكفر كبارها صرعى تحت أقدام الخيل، ركبت صهوات الفرار تُلمْلم جراحها، وتعود إلى ديارها بما تبقى من رجالها، هنالك نشطت نسعات المسلمين وأغلالهم تقيِّد من استطاعت الإمساك به من جموعهم الفارة، فانقشَعت سحابة المعركة البدرية عن سبعين قتيلًا، وسبعين أسيرًا من مشركي قريش، فكان ذلك ضربة قاصمة لم تتلقَّ قريش قبلها مثلها.
الأثر الذي تركته المعركة:
إن يوم بدر يوم مشرق في جبين الأمة المحمدية، ودرة مضيئة في عقد الكفاح الدامي في حياتها الجهادية، ومدرج متين غيَّر مسير التاريخ في تلك الأيام، وأعاد لعقل الباطل دورة التفكير من جديد، وأعطى قوة الحق شحنة جديدة من العزة واليقين، تعينها على الاستمرار في طريق المواجهة المسلحة، إنه اليوم الذي انتصف فيه المظلوم من الظالم، والمستضعَف من المستضعِف، والمعذَّب من المعذِّب، إنه يوم تخفَّفت فيه مكة من رؤوس الكفر والضلال، وتنفست جوانبها الصعداء بزهوق أرواح صناديد الغواية التي كانت تكدِّر أجواءها، فنفق فيه: أبو جهل وأمية بن خلف، وشيبة بن ربيعة وأمثالهم من الجبابرة.
يوم بدر كان يومًا أضاء على آفاق الحياة حينئذ، فأزاح من ظلمات الباطل ما أزاح، وصار درسًا داميًا تخاف أي قوة للباطل أن يتكرر في حقها.
إنه اليوم الذي وسعت أنواره أرجاء المدينة، فسُرَّ به المسلمون سرورًا عظيمًا، وحنق لأجله المنافقون واليهود حنقًا شديدًا، فعادوا إلى جحور ظلامهم خاسئين، بعد أن أطمعهم اللقاء للخروج منها، ظانين أن الدائرة ستدور على المسلمين.
وعلى المنوال نفسه كان ذلك اليوم الرمضاني البهيج يومًا أوقف القبائل الوثنية حول المدينة عن نيات السوء بالمسلمين، فأمسوا بعد ذلك يحسبون للمسلمين ألف حساب.
أما مكة فيا بؤس مشركي مكة في ذلك اليوم، إنها كانت تظن أن جيشها الجرار سيخرج إلى المدينة في نزهة للصيد، فيعود وقد قتل من قتل، وعلق في حبالة صيده أسرى من المسلمين، فيشرب المشركون الخمور، وتعزف لهم القيان؛ وبينا مشركو مكة في عنفوان أحلامهم؛ إذ بطلائع ما تبقى من مقاتليهم تدخلها تجرجر أذيال الخيبة، والرعب يلف خطاها، والخوف العريض يكسو مُحياها، ورهج الفجيعة يظلل هاماتها.
إن أهل مكة لَمَّا وصلهم الخبر الأول عن المعركة، لم يصدقوا قائله، فجعلوا يسخرون بخبره ببعض الطرائف، ولكنهم لَمَّا أضاءت لهم الحقيقة، صدموا صدمة لم يصدموها من قبلُ، فعلتهم الكآبة، ونزل بهم الحزن الشديد، وتحوَّلت مكة إلى مناحة كبيرة تسكب الدموع، وتحتسي كؤوس الوجع الكبير، فشتان بين جمع المشركين المتبقي الذي وصل مكة وهو يخلف وراءه قتلاه وأسراه، ويحمل بين يديه خزيه وهوانه، وبين جمع المسلمين الظافر الذي يعود إلى المدينة وقد فرشت طريقه من بدر إلى المدينة بالعزة والمسرة، فيدخل المدينة وهو يجر سبعين أسيرًا وخلفهم على بدر يترك سبعين قتيلًا، فتتلقاه وفود التهنئة، وعلى مُحيَّاه ترتسم ابتسامة النصر والإباء، فينزل دار الهجرة وقد قرَّت عينه برؤية قوة الضلال الكبرى تتهاوى.
وفي هذا الحدث من العبر:
1- شهر رمضان زمان نشاط وتحرك للأعمال العظيمة، وليس زمنًا للقعود والكسل.
2- انتصار المؤمنين مقترن بعنصر الإيمان الذي تصحبه معية الله تعالى.
3- غرور الباطل له أمد معين ينتهي عنده، ويسطع حينها نجم الحق المشرق.
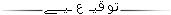
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|