 العفو والتسامح في الحروب النبوية
العفو والتسامح في الحروب النبوية


العفو هو: التجافي عن الذنب، والتغاضي عن الإساءة، وعدم المعاقبة على السيئة أو مقابلتها بمثلها[1].
والعفو والتسامح قاعدة أخلاقية كريمة، تطهِّر المرء من حظوظ نفسه ورغبته الجامحة في الانتقام الشخصي، وتجعله قادرًا على قهر دوافع الثأر والانتصار للنفس.
والشريعة الإسلامية إذ تكفُل للناس حقوقهم، وتقيم لهم أسس العدالة، وتمكِّنهم من القصاص العادل، فإنها في ذات الوقت تُرغِّب في التعامل مع المعتدي من مقام الفضل، وتندب له العفو والتسامح، فجمعت بين الحسنيين، وتكاملت في مقامي العدل والفضل.
ومن النصوص الداعية للعفو والتسامح، ما يلي:
• قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: 37].
قال القرطبي: "وهذه من محاسن الأخلاق؛ يُشفِقون على ظالمهم، ويصفَحون لمن جهل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه"[2].
• قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40].
"قال العلماء: جعل الله المؤمنين صنفين:
صنف يعفون عن الظالم، فبدأ بذكرهم في قوله: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾.
وصنف ينتصرون من ظالمهم، ثم بيَّن حد الانتصار بقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي.
وقال السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بَغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به، يعني كما كانت العرب تفعله، وسُمِّي الجزاء سيئة؛ لأنه في مقابلتها؛ فالأول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضًا.
وفي قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴾ قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو ﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾؛ أي: إن الله يأجره على ذلك.
قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة"[3].
قال الطبري: "وجزاء سيئة المُسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه، فهي وإن كانت عقوبة من الله أوجبها عليه، فهي مساءة له.
﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ يقول - جل ثناؤه -: فمن عفا عمن أساء إليه إساءتَه إليه، فغفرها له ولم يعاقبه بها، وهو على عقوبته عليه قادر؛ ابتغاء وجه الله - فأجر عفوه ذلك على الله، والله مثيبه عليه ثوابه.
﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ يقول: إن الله لا يحب أهل الظلم الذي يعتدون على الناس، فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه"[4].
وقال ابن كثير: "فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو؛ كقوله - جل وعلا -: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾؛ ولهذا قال ها هنا: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾؛ أي: لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث: ((وما زاد الله تعالى عبدًا بعفو إلا عزًّا)).
وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾؛ أي: المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة"[5].
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199].
قال الطبري: "معناه: خذ العفو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليهم، وقال: أُمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في المشركين"[6].
وقال القرطبي: "هذه الآية من ثلاث كلمات تضمَّنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات؛ فقوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين.
ودخل في قوله: ﴿ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.
وفي قوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، والأفعال الرشيدة"[7].
ومن ذلك أيضًا قوله الله تعالى - يصف أخلاق عباده المؤمنين -: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134].
قال الطبري: "أما قوله: ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ فإنه يعني: والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم، وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم.
وأما قوله: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السموات والأرض، والعاملون بها هم المُحسنون، وإحسانهم هو عملهم بها"[8].
فقوله تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾؛ أي: لا يُعملون غضبهم في الناس، بل يَكفُّون عنهم شرَّهم، ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل.
ثم قال تعالى: ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾؛ أي: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال؛ ولهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، فهذا من مقامات الإحسان[9].
فجعل الله - عز وجل - العفو عن الناس من أجلِّ ضروب الخير، وأعظم سبل البر، ورغم اختلاف المفسِّرين في المقصود بكلمة "الناس" في الآية، إلا أن الراجح من أقوالهم، وما يؤيده ظاهر المعنى في هذه الآية وفي مثيلاتها من الآيات والأحاديث - أن الآية عامة تشمل كل بني آدم، وأن العفو عن الناس برِّهم وفاجرهم، وكبيرهم وصغيرهم، من أكرم الفضائل.
ومن السنة المرغِّبة في العفو والتسامح:
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله))[10].
وعن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو[11].
عن العباس بن جليد الحجري قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: ((اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة))[12].
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتُ بيده، فقلتُ: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، فقال: ((يا عقبة، صِل من قطعَك، وأعطِ من حرمك، واعف عمن ظلمك))[13].
أما السيرة النبوية، فمليئة بمواقف العفو والتسامح:
فقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مكة ثلاث عشرة سنة مأمورين بالعفو، لا يقاتلون من يقاتلهم، ولا يردون على الإيذاء بمثله، رغم ما يتعرضون له من تنكيل واضطهاد وتعذيب يومي، ورغم ما يقاسونه من ويلات ومؤامرات قد بلغت ذروة الوحشية.
عن عكرمة عن ابن عباس أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عزٍّ ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة! فقال: ((إني أمرت بالعفو؛ فلا تُقاتلوا..))[14].
انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وتمكن من أعدائه الذين ساموا أصحابه سوء العذاب وناصبوه العداء منذ بدء الرسالة، ولم تَطب أنفسهم بعد أن هاجر وترك ماله ودياره حتى سعوا في محاربته وحشد الجيوش ضده؛ باغين استئصال شأفة المسلمين واستباحة بيضتهم.
لقد صارت الفرصة مواتية تمامًا للأخذ بالثأر، والانتقام من هؤلاء المجرمين؛ ليدفعوا ثمن جرائمهم، وينالوا جزاء ما اقترفوه من موبقات في حق أتباع هذا الدين الحنيف.
ولو أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم العقوبة، ونكل بهم جزاء وفاقًا، لكان آخذًا ببعض حقه الذي لا يلومه منصف على استيفائه، ولكنه وقف موقفًا تاريخيًّا شامخًا يعلِّم أمَّته أسمى معاني العفو والتسامح.
وقف هؤلاء المجرمون بين يديه وهم يظنون كل الظن أنهم سيؤخذون بذنوبهم وجرائرهم، وقد نشف الدم في عروقهم، وتيبست أعصابهم، واصفرت جلودهم من شدة ما كانوا فيه من الخوف والهلع، والرعب المفزع؛ خشية أن يقضي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقونه قضاءً يقضي عليهم، أو يسمهم بميسم الذل الأبدي، والهوان السرمدي، فيجعلهم عبيدًا يتقاسمهم جند الفاتحين، لكنه صلى الله عليه وسلم وقف موقف العفو المتواضع، قائلاً لهم:
((يا أهل مكة، ما ترون أني فاعل بكم؟!)).
قالوا: خيرًا؛ أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت.
قال: ((إني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء))[15].
ومن مواقف العفو العظيمة: ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل نجدٍ، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العِضَاهِ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرَّق الناس في العضاه يستظلُّون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلَّق بها سيفه.
قال جابر: فنِمنا نومةً ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي من المشركين من أعدائه يقال له: غورث بن الحارث، جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتًا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فرعب الرجل وسقط السيف من يده))، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه وقال للرجل: ((من يمنعك مني؟))، قال: كن كخير آخذ، قال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟))، قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
قال جابر: فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخلى سبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس[16].
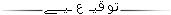
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|