 أدب الكلمة وقوة البرهان
أدب الكلمة وقوة البرهان


(للنفوس التي أرهقتها الحدثان)
مقدمة:
الأنبياء: عزيمة وتواضع، نتعلم من الأنبياء القانتين في جهاد الكلمة التواضع، والتحلي بالعزم، والصبر في الدنيا، وأن الكلمة أمانة؛ فلنضعها فيما يحب الله تعالى.
فهم مع كل ما بذلوه عندما سألهم المولى وهو أعلم بهم: ﴿ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾؟، قالوا: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ [المائدة: 109]! سبحان الله! أما نحن، ففي المعلوم والمجهول قد نستعمل الكلمة في غير موقعها، فنتنبأ ونتوقع ونبالغ وننتفش، ليؤدبنا "علام الغيوب" من خلال رسله؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: 109].
إذا أجاب الرسل عن أمور يعلمونها يقينًا يوم الجمع هذا الجواب، تأدبًا مع خالقهم، فما بالك فيما لا علم لنا به؟! إنما هو الرأي والتحليل والتوقع.
بل هو تعالى يرحمنا، ويقيم لنا وزنًا بهذا التنزيل المبارك؛ لنتذكر يوم الجمع، ولنفهم أنه ليس غيبًا واحدًا ما زوي عنا، بل هي غيوب، ومع ذلك، على قصورنا وببشريتنا التافهة - إذ تُدلُّ بنفسها على تشريعات خالقها - نغفل عن "الآزفة"، فتجد بعضنا يتدخل في الغيوب، وأكثرنا يناقش في الأمور المعلومة من أصغرها لأكبرها، وقد نتنابز بالألقاب، وقد نسخَر، وقد نتشاحن! (إلى آخر قائمة عيوب اللسان)! فيرينا سبحانه العبرة بأعيننا! ما لم نقدم لأنفسنا.. ونحاول استجلاء الدروس من هذا التنزيل الكريم، من ذلك أن نتعلم من الأنبياء - كما أشرنا - أخلاقَ البيان، وجهاد الكلمة، عسانا نحسن البيان يوم الجمع، مقتدين بهم عليهم صلوات ربي وسلامه.
قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الأحقاف: 35]، صدق الله العظيم، لا يهلِك إلا القوم الفاسقون، وهذا هو الهلاك المخزي، أبعدهم الله عنا!
وهذه حلقتنا الثانية مع أولي العزم من الرسل، وقفات ولمحات من سيرة نبينا إبراهيم الخليل الأواه الحليم[1].
درس في الإيمان مع الفتى إبراهيم: متى تصبح جاهزًا لتلقي كلمة الحق؟!
الإيمان بالله تعالى سهل، بشرط سلامة الفطرة، ولكن لا بد من الصبر في تهيئة ساحة التلقي بنبذ الأفكار البائسة والضلالات، فرغم المؤثرات المحيطة؛ كضغط القوم والأهل في تاريخ الرسل وحاضرنا، ورغم المغريات؛ كجذب الأقران والمشاهير، والتقزم أمام الأقوى الفاسق اليوم - فإن القلب السليم عندما يرفض الباطل ينجح في الاستجابة لداعي الإيمان بسهولة، والدليل: سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي تبدو قصة إيمانه أنشودة هادئة مريحة، كل مشهد فيها يصدح بالدور العظيم لسلامة الفطرة والقلب في اتباع نور الحق؛ من خلال تأمل الكون والأفلاك؛ قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: 75].. يقينًا ارتبط باليقين بأنه - سبحانه وتعالى - سيهديه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف: 26، 27]؛ فأكرَمه الله تعالى بالإيمان والنبوة والصِّديقية: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ [مريم: 41].
وإن تلقي الخليل عليه السلام عبء الاصطفاء والنبوة بهذا القلب السليم أعانه - بأمر الله تعالى - وقد "آتاه رشده" على الصَّدْع بكلمة الحق في ظروف شديدة الصعوبة، وهو وحده، وهو مجرد فتى أخذ على عاتقه أن يكون شاهدَ الإثبات الوحيد على قضية فطرة الكون والتوحيد حين قال لقومه: ﴿ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 56]، شهادة حق في قضية قد تبدو خاسرة؛ لأنها تعِجُّ بشهادات الباطل من المتنفذين.
وهو بعد أن تبرأ من آلهتهم، واجه جهلهم بعلم الله تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 80]، وقابل سلاحَهم بالتخويف بنعمة الأمن من الله تعالى لمن آمن ولم يلبِسْ إيمانه بظلم، بينما الخوف الحقيقي هو لمن أشرك بالله: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: 81 - 83].
اللهم اجعلنا من الراشدين؛ لنكون من الفريق الأحق بالأمن، سبحانك!
♦ دروس في الأدب والحِلم مع إبراهيم عليه السلام:
نحن نلمِس أدب الخليل الجم وأنَاتَه، ونتعلمهما من عدة مواقف، نكتفي ببعضها من خلال آيات قرآنية:
♦ ونبدأ بتأدبه عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى:
فأنت عندما تتأدب مع ربك، تلقائيًّا أنت مؤدب مع الكون والكائنات، وحتى مع مخالفيك منهم:
1) أدبه في الدعاء:
وجهاد الأنبياء بالكلمة أحدُ أوجهه الهامة: الدعاء، انظر إلى دعائه في سورة حملت اسمه، في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 40].
وعندما قرأتُ هذه الآية الكريمة، جعلني الخليل أسأل نفسي: هل الدعاء يتقبل أو يستجاب؟
وتعلمتُ منه - وهو الأواه الحليم، ونحن المتعجلون - أن من الأدب وأنت تدعو: أن تسأل ربك قبول الدعاء، ثم تسأله الإجابة، فبما أنه عمل صالح وعبادة فهو يتقبل (أو لا يتقبل)، ولأنه طلب ورجاء فهو يستجاب (أو لا يستجاب).
ومن يعرف ذلك ويضعه موضعه مثل سيدنا إبراهيم الحيي من ربه الأواه المنيب؟! اللهم ألهِمْنا حُسن وأدب الدعاء، واجعله متقبلاً مستجابًا.
2) أدبه في القول والعمل في مرضاة الله تعالى:
إبراهيم عليه السلام كان شديد الأدب مع ربنا سبحانه، فلا عجب أنه تعالى اتخذه خليلًا: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: 125]، لدرجة أنه أقبل ليذبح ولده دون سؤال، ولا مجرد تعليق، وهو بشر فوق أنه نبي، (ولا أقصد الطاعة؛ فهو أقبل طائعًا لربه، ولكنه حتى لم يستفهم ولو بكلمة)، وكأنه احتفظ بالكلمة للدعوة والدعاء، وقبْلها فعل الشيء نفسه عندما ألقيَ في النار، ﴿ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: 99]، ثم عندما ترك أهله في الصحراء!
أن تحرق وأنت حي هذا بلاء وابتلاء، ولكن أن تذبَح ولدك بيدك ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾ [الصافات: 106].
وعندما صدَّق إبراهيم عليه السلام رؤيا الذبح بالعمل دون تردُّد، وبما أنه: ﴿ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: 84] - فإن الله جل شأنه لم يضيِّعه، وفدى ولده فورًا ﴿ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: 107].
وبداهة إنها أمور تفُوق طاقتنا كبشر، والله تعالى لا يكلفنا ما يفُوق طاقتنا، بل هي أمثلة للاقتراب والارتقاء في إخلاص الطاعة، وأدب الدعاء، وتطويع هوى النفس ومسار الكلمة؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الممتحنة: 4].
♦ أدب إبراهيم عليه السلام وحِلمه في جهاد الكلمة والبرهان (في أربعة مواقف):
1) مع ذوي القربى: عندما توجه الخليل بجهاده بالكلمة لأقرب الناس إليه، تأمل كيف دعا أباه برفق وأدب؛ قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ ﴾ [مريم: 42] إلى: [45]، وهي لفظة تقرب وتحبب، كررها له مترفِّقًا صابرًا، فكانت مع كلمات النصح والتبليغ نبراسًا لكل مقتدٍ في الجمع بين القوة في الحق، ولينِ الجانب لمن له عليك حق.
وحين أصر الأب على الشرك، كان الابن - وهو النبي، وهو خليل الرحمن - عظيمًا في صبره على التهديد العنيف بالرجم، وقرار الطرد من أقرب الناس إليه، فقابل ذلك بـ: "السلام"، وبوعد المشفق على من يحب بالاستغفار، نجده في قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ [مريم: 47].
2) مع الملأ من المشركين حين شفع الخليل جهاد الكلمة بالبرهان العملي:
في تغييره الرائد للثوابت الفاسدة في حياة مجتمع وأمة، بلغ سعيُ إبراهيم عليه السلام الذروة حينما حطم الأوثان آلهتهم المدَّعاة، وأقول: بلغ ذروته؛ لأنه سبقه محاولات حوارية للتغيير، منها على سبيل المثال: الآيات: (51 - 55) من الأنبياء، والشعراء (70 - 74)، ورأينا كيف أقام الحجة عليهم في آيات من سورة الأنعام: (79 - 84)[2]! وخلال ذلك نحن نتعلم من سيدنا إبراهيم عليه السلام أخلاقَ وأدب الداعية، والجمع بين رقة المشاعر والعزيمة والقوة في الحق؛ إذ عندما توسعت الدائرة، وهو مجرد فتى في نظر قومه عبدةِ الأوثان، وبعد أن حاجَّهم فأعرضوا، ودعاهم لله وحده فأبَوا، وحاورهم بالحسنى عن آلهتهم: هل تسمعكم؛ تجيب دعاءكم؟ تنفعكم؟ تضركم؟! فأصروا - جمع إبراهيم عليه السلام إلى جهاد الكلمة تطبيقًا عمليًّا للإقناع، يشبه شفع الصورة بالكلمة في الوثائقيات اليوم، ولكنه إلى التجرِبة العمَلية أقرب:
قال تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات: 91 - 93]، هيا دافعوا عن أنفسكم.
ولكنه قبل وخلال ذلك وبعده بقي حليمًا، كما أنه لم يتخلَّ عن جهاد الكلمة، والمحاكمة العقلية المنطقية:
♦ فهو بداية أخبر القوم بنيَّته: ﴿ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 57].
♦ ثم إنه نبَّههم من جديد بعد التطبيق العملي عندما غضبوا - لعلهم يحاكمون عقولهم ويهتدون - بقوله: ﴿ اسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: 63]، فعقَلوا للحظات، واعترفوا فيما بينهم: ﴿ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنبياء: 64]، قبل أن ينتكسوا النكسة الكبرى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: 65]، ويُخرسوا عقولهم!
♦ وهو عندما أصروا على الشرك، رغم التجرِبة التي أثبتت أن هؤلاء ليسوا آلهة، كانت أكبر كلمة قالها لهم: ﴿ أُفٍّ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 67]، وهي - كما نعلم - أصغرُ كلمة تضجر في اللغة العربية، وأهونها!
♦ وهنا يدهشك أن الخليل - وهو العظيم في رقته في التعبد والتسبيح في ملكوت ربه - كان - في آن - عظيمًا في جرأته وصلابته في الحق؛ إذ وقف في وجه الجموع الغاضبة من عبدة الوثن وقد أقبلوا إليه يزفون: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 95، 96]، ولم يتراجع قِيد أنملة، حتى والنار تسعَّر لحرقه!
3) البرهان العقلي في مناظرة ذي المُلك الكافر:
لا شك أن مشهد الخليل مع الذي "آتاه الله الملك" لا يغيب عن الخاطر، ومما يدهشنا حقًّا رباطةُ جأشه أمام مثال الإحياء والإماتة، الذي هو تهديد مبطن من النمرود له بالقتل، وكيف رد عليه وتحداه بحجة كونية: ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: 258]، وحَجَّه، بل صعقه بالبرهان العقلي: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ [البقرة: 258]، سبحان الله!
وانظر كيف أن الإيمان الحق يثبِّت الجَنان، ويطلق اللسان في وجه عتاة الشرك، حتى مدعي الألوهية - محقهم الله، وتلك الوقفة الثابتة القوية تعلمنا أن رقة المشاعر والحِلمَ لا تعني التراخي في الحق، ولو بمجرد الركون إلى أهل الباطل، وهي مَثَل ساطع على جهاد الكلمة من إنسان وصَفه ربه بأنه كان: ﴿ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 120].
4) موقف نبي الله إبراهيم من بني الإنسان:
مع ما سبق لمن يسأل: لماذا نبي الله إبراهيم هو خليل الرحمنِ الصِّديقُ الحنيف؟ ولماذا هو الأواه الحليم؟
سبحان الله! اقرأ دعاءه الشجي الندي، الحنون الرحيم، في السورة التي سميت باسمه، تعرف لماذا!
♦ فكل منا إذ يجاهد بالكلمة أو يتابع مَن يجاهد بها ويقرأ عنه، قد تصدمه غلظة البعض، وقسوة واستهتار البعض، وقد تكون الصدمة شديدة، ولكن ما يؤنسه ويحلق بروحه حقًّا: رقة إبراهيم الخليل، وسَعة خُلُقه، وتعامله الرحيم حتى مع مَن خالفه وعصاه! فهو حطم الأصنام، ولكنه بنى الإنسان[3]، وبقي دائبًا في سعيه لهذا التغيير البنَّاء بعد أن أخذت الدعوة إلى الله تعالى مداها، وانتشرت في الآفاق، وهنا فإن الملمح التربوي الأخلاقي الذي يدهشنا هو ذلك الدعاء لله تعالى عبر سبع آيات (35 حتى 41) في سورة إبراهيم، ونتناول بعضه:
قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ [إبراهيم: 35، 36]، يا رب، وأنا دعوتُ القوم كما أمرتني لنبذها، ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي ﴾ [إبراهيم: 36]: ماذا تتوقع أنه قال؟ فعليك به؟! ألقِه في النار لشركه؟! بل قال عليه السلام: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: 36]!
سبحان الله! قمة الحِلْم والقنوت والإنابة! من يرتقي لمعشارها فيدعوَ لمن عصاه كما يدعو لمن اتبعه؟! وهنا اللمسة العجيبة، وكأنه - عليه السلام - قدم رجاءه أن يتوبَ أولئك العصاة فيغفر لهم على عظم ذنوبهم وجحودهم!
♦ ثم إنه عندما دعا لذريته بالرزق وقد أسكنهم ﴿ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ [إبراهيم: 37]، فسأل الله تعالى: ﴿ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ [إبراهيم: 37] لم يقل: ليأمنوا من الجوع، لينجوا من الموت في المَخمصة، بل بأدبه مع ربه في الدعاء الذي افتتحنا به تلك العجالة، ارتقى بهم لمرتبة الشكر؛ ليكونوا عبيدًا للمنعم، وليس عبيدًا للنعمة حين قال: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: 37]!
ففاضتِ النِّعمُ والثمرات حول البيت الحرام ببركة هذا الدعاء العظيم إلى يومنا هذا.
وكان عليه الصلاة والسلام بهذا وذاك أمَّةً.
♦ ولا تنقضي الدروس والعبر:
في أدب الخليل - عليه السلام - مع الله تعالى ومع الناس تلمس قمة التوكل والرضا والتفويض.
العجيب أنه في الدعوة إلى الله ترفَّق بأبيه الكافر، واستغفر له، ودعا له.
وفي طاعة الله كان حازمًا عازمًا؛ فترك أهله في الصحراء أولًا، ثم كاد يذبح ولده المؤمن وفِلذة كبده ثانيًا، وبالحالتين تجلَّى إخلاصه ووفاؤه العجيب؛ قال تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: 37].
يفيض قلبي وأنا أقرأ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ [هود: 75].
من للأمة اليوم بمثلك يا خليل الرحمن، ومحطم الأوثان؟!
وبعد:
أخي القارئ، كلما كدتَ تقول هُجرًا تذكَّر "أف" إبراهيم، كلما كدت تغضب من عصيان رحمٍ دعوتها وتيئس من صلاحها، تذكَّر رِفق إبراهيم وحِلمه على شِرك أبيه، وكلما ناقَشك العصاة وحاجَّك الضالون، تذكَّر دعاء إبراهيم لمن عصاه، وكلما راودَتْك نفسك على مخالفة نص (الوقوع في نهي، أو إغفال أمر) تذكَّر طاعته المطلقة لربه، وقل: يا رب، أعنِّي لأقترب منغفرانك، ولك الحمد.
♦ أخيرًا نختم بالاستحقاق الإبراهيمي:
أمام هذه المواقف النبوية الأخلاقية، التي يقصر عنها القلم، وما رافقها من تغييرات رائدة ومبدعة في فكر ومصير أمة:
• فقد استحق إبراهيم عليه السلام: أن يجري الله تعالى لأجله تغييرًا خارقًا للثوابت المادية الكونية، التي لا جدال فيها في حدود فهمنا كبشر؛ فأفقد النار خاصية الإحراق، بل وجعلها "بردًا" و "سلامًا" على إبراهيمَ الخليل تحديدًا! واستحقَّ أن يُنزِلَ - سبحانه - كبشًا عظيمًا فداءً لولده إسماعيل.
• وأوتي - بفضل الله - المزيد من المنح الإلهية، منها: أنه عليه السلام استحق من أجلِ كل ما سبق: تحطيم الأصنام، وكل ما تلاه من تغييرات جذرية ومطورة في النفوس والأرواح والعقول - أن يكون خليل الرحمن، وأن يكون "أمة" بذاته؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 120] صدق الله العظيم.
وكلما اقتربنا من ذلك المرتقى الأخلاقي السامق بالقول والعمل، كان رجاؤنا أعظمَ بفضل الله وكرمه في الدنيا والآخرة، سبحان الله!
والحمد لله رب العالَمين.
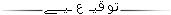
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|