 في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (3 /5)
في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (3 /5)


إذا ذُكرت الشهور، كان لشهر ربيع الأول منزلة حبيبة خاصة في قلب كل مسلم، إنه شهر العطاء بلا حدود، والخير بدون قيود، وها هي آثار عطاياه وهداياه ماثلة حتى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وهذي أواصر قرباه لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر أو جاهل، وتلكم وشائجُ نسبه تشرق وتسمو وتزهو، لا يعتريها لبسٌ أو غموض، وكيف لا يكون كذلك، وهو الشهر المبارك العظيم الذي وُلد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ليحمل بعد حينٍ من الدهر شعلة الهداية السماوية للناس، بعد أن عصفت بهم الجهالات والضلالات، وباتوا في ليل من الشقاء والفساد طويلٍ بهيمٍ؟
وإذا قِيست الأزمنة بما تقدم من الخير النافع المبارك، لا بما يدور الفلك خلالها من دورات، فإن شهر ربيع الأول تفتَّح عن خير عميم، شمل الدنيا كلها، والبشرية جمعاء ولا غرابة؛ فقد كانت رسالته للناس كل الناس، في الأرض كل الأرض، وصدق الله العظيم في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].
ولم يمضِ على الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل سنة 570 للميلاد أربعون عامًا، حتى بدأت سلسلة جديدة من البركة النافعة، والهَدْيِ الكريم، وارتفاع راية الحق، وتدفق أشعة النار؛ فلقد تنزَّل جبريل الأمين عليه السلام، في ليلة رمضانية نورانية مباركة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ليبلغه رسالة السماء الأخيرة، رسالة الإسلام التي أتمَّها الله عز وجل، وأكملها وارتضاها دينًا أخيرًا للناس، هو وحده سبيل سعادتهم الوحيد في دنياهم وأخراهم، ونهض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بالأمانة خير نهوض، فجاهد في إبلاغها بكل جهده حتى أتاه اليقين، فانتقل إلى خالقه عز وجل، بعد أن ترك الناس على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
وإنه لمن الخير المبارك أن تتفتح قلوبنا لهذه الذكرى الكريمة، تمر بنا هذه الأيَّام، فلا يكون شعورنا بها شعور الجماد تمر به دورات الزمان، ولكن شعور الإنسان الذكي البصير، ذي القلب الحي الواعي، يلتمس العظة والعبرة والدروس، ويستفيد مما يمر به، ويحدد على ضوء الرسالة الكريمة التي جاء بها صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم ملامح شخصيته كفرد، ومعالم أمته كجماعة، جاعلًا من الإسلام نظام حياته، ومن القرآن الكريم دستوره وقانونه، ومن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوته وإمامه وأُسْوَتَه، وبذلك يستفيد من الحوادث، ويتفاعل مع التاريخ، وينتفع من مرور الذكرى الطهور.
إن الإحساس الإيجابي الصادق بهذه الذكرى الغالية هو إحساس بسيرة صاحبها عليه الصلاة والسلام، وهو إحساس بنبل الغاية، وسمو الهدف، وعظمة الطريق، وضخامة المسؤولية، وبأن الغايات الكبار تحتاج إلى رجال كبار.
وهو إحساس بالعظمة الخارقة في عقيدة الإسلام ونظام الإسلام، وكل ما في الإسلام من أخلاق وموازين، وقيم ومُثُلٍ، وضوابط وتوجيهات، وهو أيضًا إحساس بهذه المدرسة التي كانت الوحيدة في العالم، عندما قدَّمت آلاف النماذج العملية لِما تريد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بتقديم نظريات للعالم، لا تجد مَنْ يحملها، أو يحولها إلى سلوك يومي، بل قدَّم نماذج عملية لكل نظرية، ولكل خُلُق، فكان الإسلام سلوكًا وعملًا، وكان استعلاء على جواذب الأرض ونوازعها، وكان تفوقًا ضخمًا مطلقًا على كل ما سواه، إلى جانب كونه نظرياتٍ ومبادئَ تقوم على سلامة العقيدة في نقائها وتوحيدها، وسمو التشريع في عدالته وواقعيَّته، وشموله وغِناه.
وأمتنا اليوم التي تود أن تنهض بعد عثار، وتصحو بعد كبوة، وتتقدم بعد تخلف، وتنطلق انطلاقة الظفر والظهور والغلبة، في جميع الميادين - يحسُن بها لتصح مسيرتها ويستقيم أمرها أن تتحسس مواقعها الفكرية، وأن تمتحن طاقاتها، وأن تقوِّم قناعاتها، وأن تصوغ مواقفها، وأن تحدد غاياتها ووسائلها، على ضوء الرسالة المباركة الطاهرة التي جاء بها صاحب الذكرى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعليها كذلك أن تمتحن صدق وجدِّية ولائها لقائدها وإمامها، وقدوتها وأسوتها، الذي كان لها في ذلك كله النموذج المتكامل في كل شيء؛ ذلك أنه ما ترك ميدانًا من ميادين الحياة الخيِّرة إلا وَلَجَهُ وضرب فيه أحسن المثل.
إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أضاء ليل الظلام الداجي يومَ كان العالم يتخبط في متاهات الضلال والحيرة، ويئِنُّ من وطأة الظلم والظالمين، يوم كان هذا العالم نهبًا مقسَّمًا لأولئك الذين استطاعوا ببغيهم وعدوانهم وتحت شتى العناوين أن يستعبدوا مَنْ دونهم من البشر، وأن يفرضوا عليهم سلطانهم بلا هوادة ولا رحمة، ولا أي تقدير لكرامة الإنسان.
لقد أضاء ذلك الليل، وجلا تلك الظلمات، وأزال هاتيك المظالم، وأطلق الإنسان من إسارِهِ، ليكون عبدًا لله تعالى وحده، وبهذه العبودية يكون حرًّا من كل عبودية أخرى لأي إنسان كائنًا من كان، وبذلك فقط تكون كرامة الإنسان.
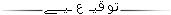
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|