 في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (1/ 5)
في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (1/ 5)


ما أطل شهر ربيع الأول من كل عام؛ إلا وجاء يحمل معه ذكرى أثيرة غالية، يعتز بها كل مسلم ويهفو إليها؛ وهي ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تلك التي كانت بدايةَ فجر سعيد طلع على الدنيا، وبزوغَ هداية أنقذت الناس من الضلال والفساد والحَيرة، ومشرِقَ حضارة كريمة عاطرة لم يعرف العالم مثيلًا لها قط، وإيذانًا بقيام دولة الحق والعدالة والمساواة، والمجتمع الراشد الأمثل.
وإذا كان العظماء يُقاسون بمقدار ما استطاعوا أن يحققوه في الواقع من العطاء المبارك النافع، فإن عظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا المقياس الصحيح هي العظمة الخالدة الكبرى، التي تتقطع أعناق جميع العظماء دونها، ويظلون في غاية العجب والدهشة والإكبار، وهم يمعنون فيها، ويستجْلُون كنوز عِبَرِها ودلالاتها، ويتوقفون عند أبعادها الشاسعة، وأمدائها الواسعة، وغِناها الذي لا ساحل له.
وإنها لكثيرة جدًّا تلك النتائج المباركة التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس فأفادهم ونفعهم، وبيَّن لهم السبيل القويم، وجنَّبهم السوء والأذى، والشرور والمهالك، وقادهم إلى طريق سعادتهم في دينهم ودنياهم.
إنها كثيرة جدًّا تفوق قدرة المرء الذي يحاول إحصاءها، فهي أكبر من طاقته وإمكاناته، وإذًا؛ فإن له العذر إذا حاول التوقف عند بعض المعالم الكبرى من هاتيك النتائج، وعفوًا إن فعلتُ ذلك، فالموضوع ضخمٌ عظيم، وحسبنا أن نجوب في بعض عطائه المبارك.
أول نتيجة كبرى من نتائج دعوته صلى الله عليه وسلم هي ذلك الجيل الربَّاني الفريد الذي ربَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان هذا الجيل أعظم جيل عرفته البشرية على الإطلاق، صحيح أن الأمة الإسلامية، ظلت طوال عمرها تُخرج من أبنائها مَنْ فيه مشابه كثيرة من صفات ذلك الجيل، في شتى ديار الإسلام، وعلى اختلاف الظروف والأحوال، ولكنْ صحيح كذلك أن ذلك الجيل الرباني الفريد لم يتكرر وجوده جماعة، وإن تكرر وجوده أفرادًا، وهذا دليل قاطع على عظمته صلى الله عليه وسلم وكريمِ نِتاجِهِ المبارك الميمون، يظهر أول ما يظهر في ذلك الجيل العجيب الممتاز، الذي غلب في نفسه أهواءها بادئ ذي بدء، ثم انطلق من بعد ذلك ليغلب العالم وليفتحه على بركة الله، وفي سبيل الله.
والدارس لحال ذلك الجيل الأول، وعظمة آثاره في الأرض، وغناها وكثرتها وعمقها كذلك، وما فيها من تفوق نفسي باهر، وارتفاع إلى أقصى وأسمى درجات الكمال الإنساني، يجد نفسه أمام فيض زاخر من المواقف والأخبار والمعلومات تتصل به، هي ذروة التفوق البشري على الإطلاق، ولربما ظن المرء بها المبالغة، لولا التوثيق الدقيق لتلك الأخبار، وهو توثيق علمي ممحص يتحدى أدق معايير النقد التاريخي، ولولا قناعته أن الإيمان صانع الأعاجيب.
كذلك كان المجتمع المسلم الذي أرسى دعائمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرةً من أعظم ثماره المباركة الكريمة، لقد كان ذلك المجتمع أعظمَ مجتمع عرفته الدنيا، وكانت معاني الكمالات الإنسانية أصلًا عميقًا فيه يكاد يكون الصفة الأساسية لجميع أفراده.
ولقد حقق هذا المجتمع – من جملة ما حقق – مبدأ المساواة تحقيقًا عمليًّا ليس له نظير، وأشْعَرَ الناس بكرامتهم وعزتهم وحقوقهم، حتى كانت المرأة تتصدى لعمر بن الخطاب وهو على المنبر، وهو أمير المؤمنين فترد عليه، فيقول: أخطأ عمر، وأصابت امرأة!
وحقق كذلك – من جملة ما حقق – مبدأ العدالة، وأرسى دعائمه، حتى لم يعد ضعيفٌ يخاف أن يُسْلَبَ مالَه وحقَّه، ولم يعد قويٌّ يطمع في العدوان على الآخرين، وخضع الجميع لشرع الله تعالى وهَدْيِ نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام.
ولقد كان هذا المجتمع المسلم بداية حضارة مشرقة نادرة، أخذت تمتد مواكبها وتتسع، وتتدفق عطاياها وتنتشر، حتى شرَّقت وغرَّبت، وأسدت للإنسانية جميلًا رائعًا لا يُنسى، وكانت معاقلها الكبرى في دمشق وبغداد، والقاهرة وقرطبة، منائر هدًى ونور وعرفان في شتى المعارف من علوم وفنون.
وإن حضارة القرن العشرين تدين في كثير من جذورها الكبرى السليمة إلى الحضارة الإسلامية؛ حيث تتلمذت أوربا على يد المسلمين في الأندلس وصقلية والحروب الصليبية بشكل خاص، وأن المنهج العلمي التجريبي الذي يقف اليوم وراء منجزات العصر؛ إنما هو من عطاء الحضارة الإسلامية كما يشهد بذلك عدد من منصفي الغرب.
وبعد؛ فما أعظم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس! وما أكرمه وأنفعه! إنه العطاء الذي ليس له مثيل قط، وإنها العظمة التي تبدو كل عظمة أخرى إزاءها ضئيلة صغيرة محدودة.
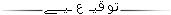
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|