 في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (4 /5)
في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم (4 /5)


لقد كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول مُفتتحَ حياة جديدة كريمة للعرب في جزيرتهم، وللناس حيث كانوا، فما كاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبلغ أربعين عامًا من عمره المبارك، حتى أرسله الله عز وجل بالدين الأخير؛ دين الإسلام لهداية البشرية كلها، وإخراجها من الظلمات إلى النور، وبدأت عملية الهداية العالمية بأمة العرب، فكانت أعظم وأول نموذج لها، مثَّلها أشرف وأتمَّ تمثيل.
وإذًا؛ فإن لنا أن نقول: لقد وُلدت بمولده الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام أمةٌ كانت تتفرق في الصحراء وشعاب الوديان، تتصارع بطونها على عين ماء، أو منبت كلأٍ، أو ناقة سُرقت، أو بئر معطلة، أو طلل هزيل، نهاية الجود عندها ذبح شاة أو بعير للضيف، وذروة البلاغة بيت من الشعر يرفع قبيلةً أو يحط أخرى، وقمة الفرح أن يظهر فيها شاب نجيب، أو ينبغ فيها شاعر، أو تُرزق مولودًا ذكرًا، وغاية الشجاعة أن تغزو قبيلةٌ من القبائل قبيلةً أخرى، فتفوز عليها، وتقتل رجالها، وتسبي نساءها وصغارها، وتغنم أنعامها.
أما عبادتها، فكانت عجبًا من العجب، لقد عبدت من دون الله تعالى حجارة صنعتها أصنامًا بأيديها، ثم عكفت عليها، تحسبها قادرة على جلب نفع، أو دفع ضر، وكان الناس من أبنائها إذا كانوا في سفر، بحثوا عن أربع حجارة، اختاروا أحسنها صنمًا لعبادته، وجعلوا الثلاثة الأخرى أثافيَّ لطبخ الطعام، وإذا لم يجدوا من الحجارة ما يريدون، جمعوا بعض الرمل على شكل كثيب صغير، ثم حلبوا عليه شيئًا من لبن نياقهم ليتماسك بعض الشيء، فإذا تم لهم من ذلك ما أرادوا طفقوا يطوفون به.
ومن حيث الدولة، لم يكن لهم أي مظهر من مظاهرها، فلا قانون ولا نظام، ولا جيش ولا حدود، ولا مؤسسات ولا حكومة، ولا أي شيء من ذلك، وكانت القبيلة كلَّ شيء في حياتهم، حقًّا كانت لهم أوضاع مستقرة لها شكل الدولة إلى حد بعيد لدى المناذرة والغساسنة وفي اليمن، لكنَّ ذلك كله سقط صريع الولاء والتبعية للآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، فاليمن كان يحكمها الفرس حكمًا مباشرًا بعد أخرجوا منها الأحباش، والغساسنة كانوا تابعين للروم، وإن كان حكَّامهم عربًا، والحال في المناذرة كالغساسنة في تبعيتهم للفرس.
هذه الأمة الشقية البائسة، المنكوبة الضالة، منَّ الله عز وجل عليها بالرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تتبدل تبدلًا سريعًا وعميقًا وواسعًا، فإذا بها أمَّة واحدة متماسكة، لها كتابٌ واحد هو القرآن الكريم، وقِبلةٌ واحدة هي الكعبة المشرفة، وقدوةٌ واحدة هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ودينٌ واحد هو الإسلام، وهدفٌ واحد هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، طلبًا لرضوان الله تعالى، فصارت بذلك الأمة الراشدة، الوصيَّة على الناس، الغالبة المنصورة، الباسطة لواءها على الأمم الأخرى، لا ظلمًا ولا تسلُّطًا ولا سرقةً لخيراتها، بل للهداية وللهداية فقط.
وانطلقت كتائب هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بالإسلام، وحدد لها انتماؤها لهذا الدين ذلك الدور الرياديَّ الضخمَ، القياديَّ الكبير، تجوب الدنيا وتنشر كلمة الحق، وتحطم صروح الجاهلية، فإذا بها بعد عهدٍ ليس بالطويل في حياة الأمم والشعوب، تملك رقعة شاسعة من الأرض، تطبِّق في هذه الأرض كلها حكم العدل والمساواة، وتهيئ للناس - حتى من غير المؤمنين بعقيدتها - فرصة العيش الحر الآمن الكريم، وإذا بها دولة القوة والمجد، وإذا بها صولة العزة والظفر، وإذا بواحد من حكامها ينظر إلى سحائب غادية، فينظر لها باطمئنان الواثق، وعزة المالك الظافر، وامتنان الشاكر المؤمن: أمطري حيث شئتِ؛ فإن خراجكِ لي!
أليس لنا – إذًا - أن نلمس في مولده الشريف صلى الله عليه وسلم مولدَ حياة جديدة لأمة العرب، نقلتهم نقلة شاسعة واسعة من حياة ضيقة جاهلة محدودة إلى حياة واسعة نيِّرة خصيبة، ومن اهتمامات تافهة كئيبة كابية إلى اهتمامات في غاية الضخامة والقوة والرفعة، ثريَّة بأكبر الأهداف على الإطلاق؟!
وهل ثمة في الكون كله هدف أعظم من هداية الناس، وقيادتهم للحق والنور، وتبصيرهم بطريق سعادتهم في الدنيا والآخرة، والسهر على شعلة الإيمان لتظل حية متوهجة يأوي إليها الناس، ويفيء إليها من أشقاهم ليل الضلال والفساد؟
إن هذا الهدف الجليل إنما اقتنعت به أمة العرب، ونهضت به، وحملت مسؤوليته الكبرى، يوم آمنت بهذا الدين العظيم، ومنحته صادق ولائها، وحملت رسالته للعالمين، فصارت بحقٍّ خير أمة أُخرجت للناس، بعد أن تتلمذت على أكرم خلق الله وأعظمهم، المولود في الثاني عشر من شهر ربيع الأول؛ محمد بن عبدالله، عليه أفضل الصلاة والسلام.
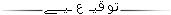
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|