 {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (خطبة)
{والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (خطبة)


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغُرِّ الميامين، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
أيها المسلمون، فكثيرٌ مِنَّا كره أمرًا من أمور حياته، ثم اكتشف بصورة وأخرى بعد حين من الدهر- طال أم قصر- أن تلك الكراهية غير الواعية بخفايا الأمور في البداية، تحوَّلت إلى شكر وثناء للخالق عز وجل في النهاية، بعد أن رأى الخير كامنًا في الأمر الذي كرهه قبل ذلك، وعلى المنوال نفسه نجد أن أحَدَنا يحب أمرًا ويسعى لتحقيقه بكل إمكانياته؛ لكن بعد حين من الدهر- طال أم قصر- سيجد أن هذا الذي أحبَّه وبذل جهده وسعيه، تحوَّل إلى شَرٍّ أو نكدٍ أو هَمٍّ، وتمنَّى لو لم يسعَ في ذلك الأمر منذ البداية! وما بين كراهية أمر أو محبته، ستكون دندنة اليوم، ومنها ننطلق ونَحُثُّ في الوقت نفسه على مدارسة قوله تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 216] ما أجملَ أنْ تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرًا تكرهه! فأنتَ لا تدري أين الخير، هل هو فيما تحب أو فيما تكره؟ فلا تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عمَّا تنطوي عليه من الحِكَم والفوائد؛ لأن ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.
فلو كُشِفَ لك عمَّا في الغيب، لم تختَرْ غير ما اختاره الله لك، فكم من إنسان ما أتاه الغيث والغوث إلا بعدما أرعد القدر وأبرق فوق رأسه، فالمِحَن قد تكون مِنَحًا، واللَّفحات يعقُبها النفحات، والكتاب والسُّنَّة والتاريخ دُوِّنت فيها وقائع لا تُعَدُّ ولا تُحَدُّ مما ظاهِرُها العذاب، وباطنها الرحمة والرزق والعُلوُّ.
من أجل ذلك كان للسَّلَف رضوان الله عليهم في هذا البابِ وقفاتٌ محكمات لبيان الحقِّ والدِّلالة على الرُّشد والهداية إلى الصَّواب، فقد نقل الإمام سفيان الثوري رحمه الله عن بعض السلف قولَه: "إنَّ منعَ الله عبدَه من بعض محبوباته هو عطاءٌ منه له؛ لأنَّ الله تعالى لم يمنعه منها بخلًا، وإنما منعه لطفًا"، يريد بذلك أنَّ ما يمنُّ الله به على عبده من عطاءٍ لا يكون في صورةٍ واحدةٍ دائمةٍ لا تتبدَّل, وهي صورة الإنعام بألوانِ النِّعَم التي يُحِبُّها ويدأبُ في طلبها، وإنما يكون عطاؤه سبحانه إلى جانِب ذلك أيضًا في صورةِ المنع والحَجب لهذه المحبوبات؛ لأنَّه وهو الكريم الذي لا غايةَ لكرمه ولا منتهى لجودِه وإحسانه, وإنَّ الواقعَ الذي يعيشه كُلُّ امرئٍ في حياته ليُقيم الأدلَّة البينة والبراهين الواضحة على صدق وصحَّةِ هذا الذي نقله سفيان رحمه الله.
• وفي قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر عبرة: فلم يكن على الأرض حين ألقت أم موسى رضيعها في اليَمِّ، مَنْ هو كاره لذلك الأمر أكثر منها؛ بحكم طبيعتها وفطرتها البشرية؛ لكنها بعد حين من الدهر، وجدت الخير كله كامِنًا في ذلك الأمر الذي كرهته نفسها بادئ ذي بدء، ورأته شرًّا له ولها، مخافة غرقه في النهر أو وقوعه بيد فرعون ومن معه من الظلمة، والتعرض للذبح كبقية مواليد بني إسرائيل؛ لكن الخير الذي رأته أُمُّ موسى تنوَّع، فحينما أصدر فرعون قراره بقتل مَن يُولَد لبني إسرائيل من الذكور، ووضع كل المحاذير حتى لا يفلت منهم أحد، فقدَّر الله سبحانه أن يُولَد هذا المولود، ويُربَّى في دار فرعون نفسه، وينشأ على فراشه، ويُغذَّى بطعامه وشرابه، ثم يكون هلاكه في الدنيا والآخرة على يديه لتصل الرسالة لجميع الخلق؛ وصدق ربنا ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.
• قصة أخرى عن موسى عليه السلام أيضًا، وشعوره يوم أن طلب من خادمه تحضير ما يسدُّ رمقهم في ذاك اليوم، من بعد مسير متعب بحثًا عن الرجل الصالح، أو الخضر عليه السلام؛ يخبره خادمه أن السمكة التي كانت معهم وكانت هي طعام غدائهم، قد عادت للحياة وخرجت بشكل عجيب من سلَّة طعامهم ناحية البحر!
لا شكَّ أن شعور عدم الارتياح كان هو الشعور الابتدائي عند موسى عليه السلام قبل أن يتنبه إلى أن ما حدث– وإن كرهه للحظات– فهو الإشارة التي كان ينتظرها، والدالة على قرب الوصول لمبتغاهما، نعم، لولا هذا الحدث غير المريح بداية، لما عاد موسى عليه السلام وخادمه لمواصلة السير وقص الأثر، حتى وجدا الخضر عليه السلام، ومعايشة قصص عجيبة عرَفوا من خلالها جزءًا يسيرًا من عميق علم الله، وهي كلها شواهد على موضوع حديثنا اليوم، فقد كره موسى عليه السلام تخريب سفينة البحَّارة المساكين، وكره قتل الغلام بدون أي ذنب، وكره قيامهم بترميم بيت دون مقابل، في قرية لم يرأف بهم أحد من أهلها؛ ليتبيَّن له نهاية الأمر أن الخير فيما قام به الخضر، وليُدرِك أيضًا ومن سيأتي بعده من بني البشر، معنى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهكذا في حياتك حينما تُفَاجأ بما لا تحب وما لا تريد تذكَّر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين، وتذكَّر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرًّا ثم تبيَّن لك أنها خير ومصلحة لك.
وأنت كذلك قد ترى ضمن مشهد إلقاء يوسف عليه السلام في الجُبِّ أو البئر، أنه أمر كان كله شرًّا وقسوة بالغة من إخوة كبار تجاه أخيهم الصغير، لتجد بعد حين من الدهر، أن الخير كان يكمن في تلك المؤامرة؛ خيرٌ تجسد بعد سنوات طوال، على شكل عِزَّة وهيبة وسلطان ناله يوسف عليه السلام حتى طال ذلك الخير أُمَّه وأباه، وكذلك إخوته الذين حاكوا ونسجوا تلك المؤامرة! كاد له إخوته كيدًا أرادوا قتله فلم يَمُت، أرادوا محوَ أثره فارتفع شأنه وعلا نجمه، أرادوا بيعَه مملوكًا فأصبح ملكًا، أرادوا أن يُزيلوا محبته من قلب أبيهم فما ازداد أبوهم إلا حبًّا وشغفًا به، فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فكل ما يحصل فهو بإرادة الله وحكمته وتقديره، قال سبحانه: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49] وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2] فكل أمر له حكمة؛ ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.
أيُّها الأحِبَّة الكِرام، لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتها، ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة، لا فئة الحامية المقاتلة من قريش؛ ولكن الله جعل القافلة تفلت، ولقاهم المقاتلة من قريش! وفق تدبير إلهي محكم، على رغم أن الصحابة الكِرام الذين شاركوا في المعركة، اعتبروا مجريات الأحداث شرًّا لهم؛ لأنهم قاب قوسين أو أدنى من الهلاك؛ فما خرجوا لمعركة؛ بل اعتراض قافلة تجارية، والفرق بين المهمتين كبير؛ لكن مع تطوُّرات الأحداث، تَبيَّن لهم بعد ذلك أن الخير كله فيما دبَّره الله لهم، فكان النصر الذي دوَّى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام؛ فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين؟! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟! وهي المغزى الحقيقي للآية، ما يفيد أن كراهيتك لأمر ما أيها الإنسان، لا تعني أنك محقٌّ ومصيبٌ فيها، فقد يكون الخير بانتظارك وأنت لا تدري؛ وبالمثل يقال عن حُبِّ أمر ما والميل نحوه، فقد يكون الشر بانتظارك من خلاله وأنت لا تدري ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليَعتمر فتعترضه قريش بصُلْحِ الحديبية، فلم تَحصل لهم العمرة وضاق بعض الصحابة بهذا الصلح؛ ولكن الله سمَّاه فتحًا، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: 27].
فعلم ما لم تعلموا، ما أجملَها من عبارة! وما ألطفَه من تقدير! ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلِّم أصحابه الكِرام رضوان الله عليهم الاستخارة في الأمور كما يُعلِّمهم السورة من القرآن، ففي صحيح البخاري: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ السلَمِىُّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وفيه يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)) نعم ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.
وفي مسند أحمد: عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ)).
فالإنسان وهو يعيش في هذه الدنيا، ومع كثرة المشاغل وتعقيدات الحياة ومتطلباتها، قد يغفل عن هذه الأمور، إلا أنه لا بد له من وقفة مع نفسه، يراجع أموره وشؤونه وأحواله، ويستشعر نعم الله عليه في المنع أو في العطاء، في النقص أو الزيادة، في التأخر أو التعجيل، إنها نعمة يغفل عنها الكثير؛ بل وربما ظنها البعض نقمة؛ لقصور نظره ومحدودية علمه، وهذا الأمر كما هو متحقق في الأفراد فهو متحقق في الأمة المختارة التي اصطفاها الله ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.
أيها المسلمون، ضاق صدر عمر بن الخطاب عندما ترمَّلت ابنته حفصة، وحزن حزنًا شديدًا عليها، لقد رآها تذبل أمامه وتفقد روحها بعد وفاة زوجها، فذهب يُسِر بخفاياه لأبي بكر الصديق، ويعرض عليه أن يخطبها، وبعد أيام كان يُعرِض فيها الصديق عنه، أيقن أنه يرفضها.. أبو بكر الصديق يرفض حفصة بنت الفاروق عمر بن الخطاب، أي نسب هذا الذي يُرفَض؟! تمرُّ الأيام والحال كما الحال، فيذهب عمر بن الخطاب إلى عثمان بن عفان، يطلبه لابنته وكله يقين بأنه لن يرفض أبدًا، يمرُّ يوم وبعده يوم فيقول عثمان: بدا لي اليوم ألَّا أتزوَّج.. أي إنه يرفضها، لا يريد الزواج بها ولا بغيرها، فيحزن ابن الخطاب، ويصيبه من الوجد ما يصيبه، ويعلم رسول الله حين يذهب إليه ويشكو حاله عنده، فيقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام: ((يتزوَّج حفصة مَنْ هو خيرٌ من عثمان، ويتزوَّج عثمان من هي خيرٌ من حفصة)) لم يكن عمر ليعلم أن الخير كامن فيما ظنَّه شرًّا، فيطلب الحبيب المصطفى يد حفصة بنت الخطاب، وينال الفاروق شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح حفصة من آل بيت النبي ومن أمهات المؤمنين، وفوق كل هذا زوج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ومَن وقفَ مع كتاب الله وسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ التاريخ الصحيح، لرأى من ذلك عجبًا عجابًا؛ ولكن هي إشارات وإلماحات؛ فاسمع إذًا:
هبَّت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتْها، ونجا بعض الركَّاب، منهم رجل أخذت الأمواج تتلاعَب به حتى أَلقت به على شاطئ جزيرة مهجورة، وعندما أفَاق الرجل من إغمائه جَثا على ركبتَيه، وطلَب من الله المعونة، وسأله أن يُنقِذه من هذا الوضع الأليم، مرَّت أيام والرجل يَقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده من أرانب، ويشرَب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشَّجر؛ ليحتمي فيه من برْد الليل وحرِّ النهار، وذات يوم، أخذ الرجل يتجوَّل حول كوخه قليلًا ريثما يَنضُج طعامه، وعندما عاد فوجئ بالنار وقد التهمت كل ما حولها، فأخذ يصرخ قائلًا: لم يتبقَّ لي شيء في هذه الدنيا، وأنا غريب وفي هذا المكان، والآن يحترِق الكوخُ الذي أنام فيه، لماذا كل هذه المصائب تأتي عليَّ؟! فنام الرجل من الحزن في العَراء وكوخه يحترق، ونام وهو يتضوَّر جوعًا، وفي الصباح كانت المفاجأة! إذ وجد سفينة تقترِب من الجزيرة، وينزِل منها قارب صغير لإنقاذه، أما الرجل، فعندما صعِد على سطح السفينة أخذ يَسألهم: كيف اهتدَوا إلى مكانه؟ فأجابوه: لقد رأينا دخانًا من بعيد، فعرَفنا أن شخصًا ما طلَب الإنقاذ.
فكل شيء يسير وَفْقَ تقديره عز وجل وهو يعلم ونحن لا نعلم، وكن على يقين بأن الله لا يُقدِّر إلا خيرًا، وأن تقديره عز وجل لا يَخرج عن أمرين اثنين، إمَّا فضله، وإما عدله، وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا، فما على المؤمن إلا أنْ يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 268]، وقال تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 216] أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فيا أيها المسلمون ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ كان هناك سلطان في زمن غابر، وبلاد بعيدة، وكان له جليس إذا ما سُئِل عن رأيه في حادث مُقلِق، يقول بثبات المؤمن وطمأنينة العارف بالله: "لعلَّه خير لك، وأنت لا تعلَم" وحدَث في يوم من الأيام أن خرَج هذا السلطان ومعه جلساؤه للصيد، وعندما أَطلَق سهمه على طريدته، فأصاب يدَه وترُ القوس، فأتلَف إصْبَعَه بعد أن خرج منها دمٌ ليس بالقليل، وبينما هو جالس يُطبِّبها، التفَت إلى من حوله والألمُ يَعصره التفاتةَ المستطلِع لرأيهم، وكان من بينهم الجليس الصالِح، فقال هذا الجليسُ: أيُّها السلطان، لعلَّ ذلك خير لك، وأنت كاره له؛ ولكن السلطان لم يرَ في هذا الحادث خيرًا، فغَضِب على هذا الجليس، فأمَر به إلى السجن، وبقي فيه سنة كاملة، وفي يوم من الأيام خرج السلطان للصيد، وبينما هم في أثَر الصيد يُطاردونه، انفصَل كلُّ واحد منهم؛ ليَلحق بقِسم من هذا الصيد الوفير، فانفصَل السلطان عمَّن معه؛ فخرج عليه قُطَّاع طريق على غير مِلَّته، ولهم طقوس وثنيَّة، وتَمتَمات شِركيَّة، وكان من بين طقوسهم أن مَن أمسَكوه في هذا اليوم ضحَّوا به لآلهتهم، فما أن رأوا السلطان حتى حاصَروه وأمسَكوا به ليجعلوه قُربانًا لآلهتهم، فما كان من السلطان إلا أن جعل يُخبِرهم أنه السلطان وأن إطلاقه سوف يدرُّ عليهم رزقًا كثيرًا، فلم تشفع له شيئًا؛ لأن ولاءهم لآلهتهم كان أقوى من المال مهما كان قدْرُه؛ وكان لا بد لمن يُقدَّم قربانًا لآلهتهم أن يكون جسمه سليمًا من الآفات والعيوب؛ ليكون أكمل وأعظم في محبَّتهم وولائهم لآلهتهم، فلما تبيَّن لهم أن إحدى أصابعه معطوبة، وأن فيها عيبًا ليس هيِّنًا، فليس جُرحًا فيَبرأ، ولا مرضًا فيشفى، بعد ذلك أَطلَقوه مشيَّعًا باللعنات؛ لما أضاعه عليهم من الوقت في إمساكه، وإفساده فرحتَهم بما ظفِروا به؛ فعاد إلى بلاده بعد أيام، وأول من تذكَّر ذلك السجين، الذي قال كلمة حقٍّ فكوفئ بالسجن، فأمر بإطلاقه وإحضاره حالًا؛ لما ثبَت له من فِراسته وصدْقه الذي دفعه إليه الإيمان بربِّه، وأنه لا يَقضي شيئًا عبثًا؛ وإنما لحكمة، فإنْ عُلِمتْ كانت نورًا على نور، وإنْ جُهِلت آمِن بأنه من عند حكيم عليم، فما كان من السلطان إلا أن اعتَذر إليه عن سجنه، فما كان من الجليس إلا أن ردَّ ردَّ المُستيقِنِ البصير فقال: (لعلَّ حبْسك لي خير من عفوكَ عني) وعندها اندهَش السلطان وقال له: فهِمتُ أن قطْع إصبَعي كان لي خيرًا، ولكن كيف يكون سجنك خيرًا لك؟! قال: يا جلالة السلطان، تعلم أنني مرافِقك الخاص أينما ذهبت، فلو لم تَحبسني لربما كنت أنا الذي أمَسك به القوم وقدَّموني قربانًا، وأنا صالِح لشروطهم، فليس بي عَطَب يَمنعهم من التقرُّب بي؛ (من كتاب " ولكن سعداء.." للكاتب أ. محمد بن سعد الفصّام).
أعود فأقول: هذه قصة تَستأنِس بها النفوس، وتعلَم أنَّ ما قضاه الله للعبد خيرٌ كله، سواء علِم ذلك الخير أو لم يَعلَمه؛ يقول تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ [الفجر: 15، 16] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له))؛ رواه مسلم.
أيُّها الأحِبَّة الكِرام: الدنيا دار ابتلاء من صبر فله خير الجزاء، وربما منَّ عليه الله بعظيم الكرم في الدنيا والآخرة، فلا تيأس إن طال بك البلاء، ولا تحزن وإن فقدت شغف الحياة، ولا تبْكِ على عطاء حرمك الله إياه، فلعلَّ العطاء في المنع، ولعل الخير يكمن في الشر، ولعل حبل صبرك بلي ويريد الله أن يعوِّضك، فاصبر فقد سرت الكثير ولم يبقَ إلا القليل، قد يضيق بنا الحال، وتسود الدنيا في أعيننا، لرغبة أردناها ولم نحصل عليها، فيصاب القلب بخيبة الأمل، ويمرض الجسد، وتذبل الروح، ولكن أييأس قلب ربُّه الله؟ أيمرض جسد ربُّه الرحمن؟ أتذبل روح ربُّها الجبَّار؟ لا والله فعطايا الله كلها خير، وإن كان منعه هو العطاء، وعوضه لا تسعه أرض ولا سماء، وجبره يداوي قلوب أنهكها الإعياء، وتأمَّل في أمر يعقوب عليه السلام يوم أن خاف على يوسف أن يأكله الذئب؛ ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ [يوسف: 13]، فقد يوسف وفقَد بصره؛ ولكنه يوم أن فوَّض أمره إلى الله فقال: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ [يوسف: 83] عاد له يوسف وعاد له بصره؛ ففوِّض أمرك إلى الله في كل ما يَجري حولك، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقم الصلاة.
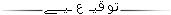
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|