 الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (5)
الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (5)


مائة وواحد وعشرون: ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾، هذا اللفظ عام يشمل كل شيء من الرجال، والنساء، والأموال، وجميع الأصناف.
مائة واثنان وعشرون: قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41]، هذا بيان كيف تقسم الغنائم، وقد تقدم تفصيل ذلك.
مائةوثلاثوعشرون: تولي الرب سبحانه - عز وجل - قسمة الغنائم بنفسه، دليل على أهمية ذلك، ومن فوائده قطع النزاع.
مائةوأربعوعشرون: فيها أيضاً أن قطع النزاع بين المؤمنين مما يحبه الله، ودعا إليه القرآن.
مائةوخمسوعشرون: قوله: ﴿ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: 41]، فيها بيان طريقة القرآن في دعوة الناس إلى الله، وهي ربط الفرع بالأصل، وهي كذلك طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في قوله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".[1] الحديث.
مائةوستوعشرون: في الآية أن امتثال الأوامر، واجتناب النواهي من مقتضيات الإيمان بالله والإيمان بالقرآن.
مائةوسبعوعشرون: قوله: ﴿ عَلَى عَبْدِنَا ﴾، شهادة من الرب جل وعلا لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بتمام عبوديته، وكمالها لربه - عز وجل -، وقد تكرر ذلك في القرآن، واللفظ هنا يشعر بالاختصاص عند التأمل.
مائةوثمانوعشرون: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ على ظاهره فإن معركة بدر لم تلبث إلا يوماً أو بعض يوم، فقد علمنا مما تقدم أنها بدأت صباح الجمعة، فدارت المعركة إلى الظهر حيث انهزم المشركون، وانتهت مطاردتهم إلى الليل، على أن اليوم يطلق على الوقعة بصرف النظر عن مدتها، فقال العرب: يوم ذي قار، ويوم حليمة، وغيرها من أيام الله، والملاحظ في حروب العرب أنها سريعة الانقضاء، قليلة الخسائر في الغالب، بعكس حروب العجم.
مائة وتسع وعشرون: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ فيه فضل غزوة بدر، حيث سماها الله باسم يقتضي ذلك، ومعنى الفرقان ما وقع من التفريق بين أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقريش تفريقاً ظهر به ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الحق، وما عليه قريش من الباطل.
مائة وثلاثون: قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنفال: 41]. بيان لقدرته المطلقة على كل شيء بلا استثناء.
مائةوواحدوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال: 42].
العدوة هي طرف الوادي، والركب المراد به عير أبي سفيان، وهذا التصوير البليغ له من الفوائد:
أ- بيان الحال لمن بعد ولم يستطع الوقوف على موقع المعركة، فهذا الوصف العجيب يجعله كأنه يرى ويشاهد.
ب- قوله تعالى: ﴿ الدُّنْيَا ﴾، أي الأقرب إلى المدينة، (والقصوى) أي الأبعد بالنسبة للمدينة، وبالتالي فهي الأقرب إلى مكة، والمعنى أن كل فريق يستطيع العودة إلى بلده، ليس بينه وبينها حائل يمنعه، ومع ذلك نفذت مشيئة الله بالتقاء الفريقين، ليحق الحق، ويبطل الباطل، ولو كره المجرمون.
مائةواثنانوثلاثون: قوله: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال: 42]، قال الرازي: "لا شك أن عسكر الرسول - عليه السلام - في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف؛ بسبب القلة وعدم الأهبة، ونزلوا بعيدين عن الماء، وكانت الأرض التي نزلوا فيها أرضاً رملية تغوص فيها أرجلهم، وأما الكفار فكانوا في غاية القوة؛ بسبب الكثرة في العدد؛ وبسبب حصول الآلات والأدوات؛ لأنهم كانوا قريبين من الماء؛ ولأن الأرض التي نزلوا فيها كانت صالحة للمشي، ولأن العير كانت خلف ظهورهم، وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. ثم إنه تعالى قلب القصة، وعكس القضية، وجعل الغلبة للمسلمين، والدمار على الكافرين، فصار ذلك من أعظم المعجزات، وأقوى البينات على صدق محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر.
فقوله تعالى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: 42]، إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة، والمؤمنون الذين بقوا في الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة، والمراد من البينة هذه المعجزة"[2].
مائةوثلاثوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾ [الأنفال: 42].
يحتمل أن المراد بذلك الزمان والمكان، ويحتمل أن المراد الزمان فقط، والثاني أرجح؛ لأن اختيار الفريقين اللقاء في بدر له أسباب سبق ذكرها في موضع سابق.
مائةوأربعوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ [الأنفال: 42]. فيه من الفوائد أن الله تعالى قدر الأشياء قبل وقوعها، وهو صريح قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ﴾ [الحديد: 22]. وهذه إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها.
مائةوخمسوثلاثون: أن الأخذ بالأسباب المشروعة أمر مشروع، كل بحسبه، فإن الرب جل وعلا مع علمه بما سيقع، لم يمنعهم من أخذ الأسباب التي يرونها.
مائةوستوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: 42]، أراد - عز وجل - أن يظهر بوقوع هذه المعركة على هذا النحو، أن محمداً وأصحابه على الحق، وأن عدوهم على الباطل؛ إقامة للحجة، وقطعاً للأعذار.
مائةوسبعوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: 42]، فيها:
أ- إثبات اسمين لله تعالى من أسمائه الحسنى التي يدعى بها.
ب- أن هذين الاسمين الكريمين تضمنا صفتين عظيمتين، الأولى: السمع، الثانية: العلم.
مائةوثمانوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾ [الأنفال: 43]. فيها من الفوائد:
أ- أن الرؤيا الصالحة من الله.
ب- رؤيا الأنبياء وحي من الله.
ت- أن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم، كانت في المنام لا [في] اليقظة.
مائةوتسعوثلاثون: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: 45].
فيها وجوب الثبات عند لقاء العدو، وأن من أعظم ما يعين على ذلك كثرة ذكر الله - عز وجل -.
قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ فيه بيان أن ثواب المجاهد الثابت لا يقتصر على الآخرة، بل يعم الآخرة والدنيا، وهو ما يشمله معنى الفلاح هنا.
مائةوأربعون: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: 47-48].
في هاتين الآيتين يذكر ربنا - عز وجل - حال الجيش المكي، والصفات التي كانت سبباً لهزيمته:
أ- الكبر، وهو ما يجعل المرء يحتقر الآخرين، وإن كانوا خيراً منه، ويرد الحق وإن تبين له، وهذا الواقع جاء مفصلاً في أحاديث الغزوة، فراجعها.
ب- مراءاة الناس بما يعملون، وفاعل هذا لا شك أنه ناسٍ ربه، جاحد نعمته.
ت- الصد عن سبيل الله، وفي هذا إعلان المحاربة لله تعالى، والظلم لعباده، فمن سيكون الخاسر إذن؟
مائةوواحدوأربعون: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: 48].
فيه أنهم كانوا يرون أنفسهم أولى بالحق من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولم يشفع لهم ذلك؛ لأن ما رأوه لم يكن مبنياً على الدليل والبرهان، وإنما كان مبيناً على شبهات وتخيلات، لا يسندها دليل، ولا برهان، كقولهم: نحن أهل حرم الله، وكاستشهادهم باليهود، مع علمهم بكذبهم.
مائةواثنانوأربعون: قوله: ﴿ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: 48]، هذا الحال الذي ذكره اللهُ يشاهد كثيراً من المدعين للشجاعة أو الكرم، أو غيرها من الصفات التي يحاولون الظهور بها، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الحقائق، ساعة الجد والعمل، فأشبهوا الشيطان بطريقتهم هذه، وبئس الشبيه.
مائةوثلاثوأربعون: أن الشيطان قد يتصور بصورة البشر، فيظهر للناس ليضلهم ويفتنهم[3].
مائةوأربعوأربعون: قوله تعالى عن الشيطان: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾، الخوف لا ينفع؛ لأنه خوف مؤقت، وهذا الحكم عام في جميع أعمال الإيمان، فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا استمر عليها حتى الممات.
مائةوخمسوأربعون: شدة تمسك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بدينهم واعتصامهم به، يؤخذ ذلك مما حكاه الله عن المنافقين أنهم قالوا للمؤمنين: ﴿ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ ﴾ [الأنفال: 49].
مائةوستوأربعون: أن من التوكل ما يبلغ بالمرء إلى اتهامه أنه مغرر بنفسه مهلك لها، ولكن إذا علم العبد من نفسه الصدق في توكله فلا يبالي بما قيل.
مائةوسبعوأربعون: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مع فضلهم لم يسلموا من لمز المنافقين.
مائةوثمانوأربعون: أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، ودواؤها إخلاصها لله - عز وجل -، قال تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [النساء: 146].
مائةوتسعوأربعون: أن من مال إلى المنافقين، وتشبه بهم في أقوالهم، وأفعالهم مريض القلب، ويخشى عليه إن استمر على ذلك أن يكون منهم.
مائةوخمسون: في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: 167].
أ- أن الحكم الوارد في هذه الآية شامل لجميع الأنبياء؛ لأن قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ ﴾ نكرة في سياق النفي، تفيد العموم.
ب- وفيها أن الجهاد من سنن المرسلين.
ت- أن العداوة بين الحق والباطل كانت ولا تزال مع كل مرسل ومصلح.
ث- وفيها أن الأسر شريعة الأنبياء، إلا أن أحكامه قد تختلف من نبي إلى نبي.
ج- وفيها أن الإثخان في العدو، وقتل الرجال أحب إلى الله تعالى من الأسر، وقد تقدم بيان ذلك.
ح- وفيها أن ما يريده الله لعباده أفضل مما يريدونه لأنفسهم.
خ- وفيها أن من طبيعة البشر إيثار العاجلة على الآخرة، ولكن ينبغي للمؤمن ألا يغلب عليه ذلك، فيقع فيما نهاه الله عنه.
مائةوواحدوخمسون: قوله تعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: 68].
أ- فيها إثبات علم الله - عز وجل - السابق لكل شيء.
ب- وفيها أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلقها.
ت- وفيها فضل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حيث سبق لهم في علم الله أن لا يعذبهم.
ث- أن العبد قد يصدر منه ما يوجب العقوبة ثم يكون لديه موانع تمنع وقوعها، وبيان ذلك في هذه القصة، جاء في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"[4].
ج- وفيها أن الله لا يعذب أحداً إلا بذنب لقوله: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 68].
مائةواثنانوخمسون: قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 69].
أ- فيها أن الغنائم للغانمين، وقد تقدم تفصيل ذلك.
ب- فيها أن الغنائم أفضل المكاسب، لقوله: ﴿ حَلالاً طَيِّباً ﴾.
مائةوثلاثوخمسون: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 70].
أ- فيها موعظة الأسرى والتلطف معهم بإيصال الحق إليهم.
ب- وفيها أن الله تعالى إذا أخذ من عبده شيئاً أعطاه خيراً منه وأفضل، إذا علم من قلبه الإخلاص والصدق، لقوله: ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ﴾.
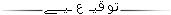
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|