 فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (1)
فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (1)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
«كان الله عز وجل قد وعد رسوله - وهو الصادق الوعد - أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجًا، ودانت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين، اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانًا لأهل الفتح، وليُظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعدُ أحدٌ من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين.
واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولًا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعُددهم وقوة شوكتهم، لتُطامن[1] رؤوسًا رُفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا رأسه منحنيًا على ناقته حتى إن ذقنه تكاد أن تمس وسط رحله تواضعًا لربه وخضوعًا لعظمته، واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده، ولم يُحله لأحدٍ قبله ولا لأحدٍ بعده[2].
وليبين سبحانه لمن قال: «لن نُغلب اليوم من قلة»[3] أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم، فإنها لم تُغن عنكم شيئًا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبهم أُرسلت إليها خلع الجبر مع بريد: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: 26].
وقد اقتضت حكمته أن خِلَع النصر وجوائزه إنما تُفَضُّ[4] على أهل الانكسار؛ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ [القصص: 5 - 6].
ومنها: أن الله سبحانه لمَّا منع الجيش غنائم مكة، فلم يغنموا منها ذهبًا ولا فضة، ولا متاعًا، ولا سبيًا، ولا أرضًا، كما روى أبو داود[5] عن وهب بن مُنبه قال: «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا»، وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب، وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرَّك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم، وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم، نُزلًا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده.
وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه، وبردت الغنائم لأهلها، وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل: لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة، فجاؤوا مسلمين، فقيل: إن من شُكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و﴿ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 70].
ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدرٍ، وختم غزوهم بغزاة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال: «بدر وحنين»، وإن كان بينهما سبع سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأولى: خوَّفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بُدًّا من الدخول في دين الله.
ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرَّحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم، وعرَّفهم تمام نِعَمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، وأنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نُصروا عليهم بالمسلمين، ولو أُفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله.
وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين.
وفيها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك.
ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرًا وشرعًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلًا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة:67]، وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا، ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليمًا للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية.
ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء وقد ذُكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير[6] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعامًا قُدِّم له حتى يأكل منه من قدَّمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك، فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67]، فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة، فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر عليه، فأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها.
ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر دينه على الدين كله ويُعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العُدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزوة ورَّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها مُفضية إلى ذلك مقتضية له، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يُعطل الأسباب التي جعلها الله بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يُبلِّغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.
وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه - زَعَم - لأن المسؤول إن كان قد قُدِّر ناله ولا بُدَّ، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخر وهو الحق: أنه قد قُدِّر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب وإن عطَّل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب.
وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونًا على قتله، كما عقر عليٌّ بعير حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه.
وفيها: عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، ولم يعاجله بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم.
ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته وقد تولى عنه الناس وهو يقول: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ.
وقد استقبلته كتائب المشركين.
ومنها: إيصال الله سبحانه قبضته صلى الله عليه وسلم التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين[7].
ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم، وعلى هذا فلو مات من الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمُه لورثته.
وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟
فقال الشافعي ومالك: «هو من خمس الخمس»[8]، وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا من خمس الخمس.
وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفَّل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده[9] لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه؛ وهكذا وقع سواءً، كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي»[10].
فما ظنك بعطاء قوَّى الإسلام وأهله، وأذل الكفر وحزبه، واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم؛ فللَّه ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله.
ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله، يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل.
ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فإنك لم تعدل»، وقال مُشبهه: «إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله»[11]، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله ومنعه لله.
وللهسبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارًا من السماء تأكلها[12]، وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثًا ولا قدَّره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه وعزَّته وحكمته ورحمته؛ ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاء والبعير، كما يُعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويُحرمون، ورسوله منفذ لأمره.
فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه، هل يسوغ له ذلك؟
قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرَّهم ساغ له ذلك، بل تعيَّن عليه، وهل تُجوز الشريعة غير هذا؟! فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق.
قوله صلى الله عليه وسلم:«فَلَهُ سَلَبُهُ» دليل على أن له سلبه كله غير مخموس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَع»[13].
وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها.
والثاني: أنه يُخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة.
والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم يخمسه، وهو قول إسحاق وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى سعيد في سننه[14] عن ابن سيرين أن البراء ابن مالك بارز مرزبان الزارة[15] بالبحرين فطعنه فدقَّ صلبه وأخذ سُواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى البراء[16] في داره، فقال: «إنا كُنَّا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا وأنا خامسه»، فكان أول سلب خُمس في الإسلام سلب البراء، بلغ ثلاثين ألفًا.
والأول أصح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وقال: هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه.
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خُمس الخمس، وقال مالك[17]: هو من خمس الخمس.
ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك، فالسلب أولى، والأول أصح للعموم، ولأنه جارٍ مجرى قول الإمام: من فعل كذا أو دل على حصنٍ.. فله كذا، والسهم مستحق بالحضور وإن لم يكن منه فعل والسلب مستحق بالفعل، فجرى مجرى الجعالة.
وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا، وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم»[18][19].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
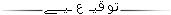
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|