 الخلال النبوية (7)
الخلال النبوية (7)


صبر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قبل الهجرة
الحمد لله اللطيف الخبير، يُصيب أولياءه بالشدائد؛ ليبلو صبرَهم، ويستخرج ضراعتهم، ويرفع ذكرهم، ويُعلي في الجنة منازلَهم؛ نحمده على المنع والعطاء، والضراء والسراء، فهو - سبحانه - أعلمُ بما هو خير لنا، وأنصح لنا من أنفسنا، فالخيرُ بيديه، والشر ليس إليه، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، يجزي على طاعته جزاءً غير منقوص، ويُعطي عطاء غير مجذوذ، وهو الجواد الكريم، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسلَه الله - تعالى - بالهُدى ودين الحق، فبلَّغ رسالاتِ ربه، ونصح لأمته، وصبر على أذى قومه، صلَّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله - تعالى - وأطيعوه، واستقيموا على دينكم، واصبروا على أذى المؤذين فيه من الكُفَّار والمنافقين؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: 24].
أيها الناس:
كلُّ دعوة من الدعوات - سواء كانت دعوة حق أم كانت دعوة باطل - لها رجالها الذين يدعون إليها، ويُقنعون الناسَ بها، ويصبرون على الأذى فيها، ويُضحُّون بأموالهم وأنفسهم لأجلها، ولا يشتكون ما يصيبهم بسببها.
والدعوة لعبادة الله - تعالى - وحدَه هي أعظم الدعوات وأجلُّها، وأكثرها استحقاقًا لبذل كل نفيس في سبيلها؛ لأنَّ ثَمنها رضا الله - تعالى - وجنته، وأيُّ فوز أعظم من رضا الله - تعالى - عن عبيده، ومكافأتهم بالقرب منه في جنات الخلد، والتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم؟! جعلنا الله - تعالى - جميعًا ووالدينا والمسلمين من أهل هذا الفوز العظيم.
وأعظم الصبر وأكمله وأفضله صبر الأنبياء - عليهم السلام - لأنَّه احتمال للمكاره في ذات الله - تعالى - دون ضَجَر ولا شكوى، وقد منحهم الله - تعالى - من الصبر أضعاف ما مُنح غيرهم؛ لأنَّهم يحملون أثقلَ ما يَحمله بشر، فيبلغونه للناس، ويصبرون على أذاهم؛ بسبب تبليغه، وقد قال الله - تعالى - لنبيه محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [المزمل: 5].
وقد حمل نبينا - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمانة هذا القول الثقيل من ربِّه - جل جلاله - فبلغه للناس، ودعاهم إليه، وصبر على أذاهم فيه: أذى القول، وأذى الفعل، ومن أذى القول أنَّهم كذَّبوه، واتَّهموه بالجنون والسحر؛ ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: 8]، ﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ [الصافات: 36]، ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾ [الدخان: 14]، ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [ص: 4]، وزعموا أنَّ ما يأتيهم به من كلام الله - تعالى - هو من الوساوس والأحلام، وأنَّه نظم شعر وسجع كهانة؛ ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء: 5]، فصبر - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليهم رغم ما رَمَوه به من هذه الأوصاف البشعة زورًا وبُهتانًا؛ ليصرفوا الناس عن دعوته، ويؤلبوهم عليه.
وإذا قَدِمَ غريبٌ يريد البيتَ تواصوا بينهم على تشويه سُمعة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والطعن في عقله، وتحذير الناس منه؛ حتى ينصرفوا عن دَعوته، ومن أعظم ما يواجهه داعيةُ الحق أن يفتريَ خصومه عليه الكذب، ويلصقوا به ما ليس فيه، فينصرفَ الناس عنه بسبب ذلك، وصَبَر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذلك كله، ولم يتنازل عن دعوته، ولم يضعف في تبليغها، ولم يغيِّر منهجه إرضاء للناس، كما هو حال بعض المنتسبين للعلم والدَّعوة في هذا الزمن؛ إذ حرَّفوا دين الله - تعالى - وأضلوا الناس؛ إرضاء للبشر، ومسايرةً لأهوائهم، ولهثًا وراء الأضواء والشهرة، ولو بالباطل.
وفي أول الدعوة جاء الحارِثُ بن الْحَارِثِ الْغَامِدِيُّ مع أبيه إلى مكة، ورأى الناس مُجتمعين على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "قلت لأَبِي: ما هذه الْجَمَاعَةُ؟ قال: هَؤُلاءِ الْقَوْمُ قَدِ اجْتَمَعُوا على صابئ لهم، قال: فَنَزَلْنَا، فإذا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدعو الناس إلى تَوْحِيدِ الله - عزَّ وجلَّ - وَالإِيمَانِ بِهِ وَهُمْ يَرُدُّونَ عليه وَيُؤْذُونَهُ، حتى انْتَصَفَ النَّهَارُ وَانْصَدَعَ عنه الناس..."؛ رواه الطبراني، وصححه أبو زرعة الدمشقي.
ولكنَّ أذى المشركين لم يقتصر على القول وحدَه، بل امتدَّ إلى الفعل، فكانوا يُعذبون أصحابه - رضي الله عنهم - أمامه، ويتآمرون عليه، ويتنافسون في إلحاقِ الضَّرر به، فصبر - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليهم صبرًا جميلاً، حدَّثَ ابن مسعود - رضي الله عنه –: "أَنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وأبو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ له جُلُوسٌ إِذْ قال بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلا جَزُورِ بَنِي فُلانٍ فَيَضَعُهُ على ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إذا سجد؟ فانبعث أَشْقَى الْقَوْمِ فجاء به فَنَظَرَ حتى سجد النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَضَعَهُ على ظَهْرِهِ بين كَتِفَيْهِ وأنا أَنظُرُ لاَ أغيِّر شيئًا، لو كان لي مَنَعَةٌ، قال: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، ويُميل بعضهم على بَعْضٍ وَرَسُولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حتى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عن ظَهْرِهِ"؛ رواه الشيخان.
وفي موقف آخر من الأذى والصبر عليه قال عُرْوَة بن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -: "سَأَلْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عن أَشَدِّ ما صنع المشْرِكُونَ برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: رأيت عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ جاء إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يُصَلِّي فَوَضَعَ رداءَه في عُنُقه، فَخَنَقَهُ به خَنْقًا شديدًا، فجاء أبو بَكْرٍ حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله وقد جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ من رَبِّكُمْ"؛ رواه البخاري.
وذات مرة اجتمعوا عليه يَضربونه - صلَّى الله عليه وسلَّم - حتى كادوا أن يقتلوه؛ كما روى أنس - رضي الله عنه - قال: "لقد ضربوا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مرة حتى غُشي عليه، فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فجعل يُنادي: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟! فقالوا: مَن هذا؟ قِيلَ: ابن أبي قحافة المجنون"؛ رواه أبو يعلى.
ولما عزم صناديدُ قريش على قتله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عرض نفسه على قبائل العرب، وعلى أهل الطائف؛ ليمنعوه من القتل، لا لشيء إلا ليبلِّغ عن الله - تعالى - ما تحمل من دينه، فيَهدي به الناس؛ روى موسى بن عقبة عن الزهري - رحمه الله تعالى - قال: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في تلك السِّنِينَ يعرض نفسه على قبائل العرب في كلِّ موسم، ويكلمُ كلَّ شريف قوم، لا يسألهم مع ذلك إلاَّ أن يروه ويَمنعوه، ويقول: ((لا أكره أحدًا منكم على شيء، مَن رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكرهه، إنما أريد أن تحرزوني مما يُراد بي من القتل؛ حتى أبلغ رسالات ربي، وحتى يقضيَ الله - عزَّ وجل - لي ولمن صحبني بما شاء الله))، فلم يقبله أحدٌ منهم، ولم يأتِ أحد من تلك القبائل إلاَّ قال: قوم الرجل أعلم به، أترون أنَّ رجلاً يُصلحنا وقد أفسدَ قومه ولفظوه؟! فكان ذلك مما ذخر الله - عزَّ وجل - للأنصارِ وأكرمَهم به، فلما تُوفي أبو طالب ارتدَّ البلاءُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد ما كان، فعَمَدَ لثقيف بالطائف رجاء أن يأووه، فوجد ثلاثةَ نفر منهم سادة ثقيف يومئذ، فعرض عليهم نفسَه، وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه، فقال أحدهم: أنا أمرُق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قطُّ، وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟! وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدًا، والله لئن كنت رسولَ الله، لأنت أعظم شرفًا وحقًّا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله، لأنت أشر من أن أكلمك، وتهزَّؤوا به، وأفشوا في قومِهم الذي راجعوه به، وقعدوا له صفين على طريقه، فلمَّا مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين صفيهم، جعلوا لا يرفع رجليه ولا يَضَعُهما إلا رضخوهما بالحجارة، حتى أدموا رجليه، فخلص منهم، وهما يسيلان الدِّماء، فعَمَد إلى حائطٍ من حوائطهم، واستظلَّ في ظل حَبَلَةٍ منه وهو مكروب موجع، تسيل رجلاه دمًا"؛ رواه أهل السير.
وقد لخص النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما ناله من الأذى في سبيل دعوته بكلمات جامعة، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيها: ((لقد أُوذِيتُ في الله - عزَّ وجلَّ - ومَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَأُخِفْتُ في الله ومَا يُخَافُ أَحَدٌ))؛ رواه أحمد وصححه ابن حبان.
فلم يتنازل - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن شيء من دعوته، وصبر على أذى المشركين فيها؛ امتثالاً لأمر ربه - تبارك وتعالى - حين أمره بالصبْر، وحرصًا على إنقاذ أُمَّته بالإيمان من عذاب الله - تعالى - فجزاه الله - تعالى - عنَّا وعن المسلمين خيرَ ما يَجزي نبيًّا عن أمته، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار.
وأقول قولي هذا وأستغفر...
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مُباركًا فيه كما يُحب ربُّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتقوا الله - تعالى - وأطيعوه؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].
أيها المسلمون، صَبَرَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على أذى المشركين طاعةً لله - تعالى - إذ أمره بذلك في كثيرٍ من آي القرآن؛ ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً ﴾ [المعارج: 5]، ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر: 7]، ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24]، والملاحظ في آيات الصبر أنَّ كثيرًا منها قد ضُمِّن وعدًا بحسن العاقبة؛ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ العَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: 49]، ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ﴾ [الرُّوم: 60]، وفي كثير منها أمرٌ بلزوم ذكر الله - تعالى - وعبادته؛ لأنَّ الذكر والعبادة زاد قوة، ووقود صبر؛ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴾ [ق: 39].
إنَّه لا يمكن أن يقوم على دعوة الإسلام أحدٌ إلا والصبر زاده وعتاده، والصبر جُنَّته وسلاحه، والصبر ملجؤه وملاذه، فهذه الدعوة الربانية جهاد، جهادٌ مع النفس وشهواتها، وانحرافاتها، وضعفها، وشرودها، وعجلتها، وقنوطها، وجهاد مع أعداء الدعوة، ووسائلهم، وتدبيرهم، وكيدهم، وأذاهم، وجهاد مع النفوس عامَّة، وهي تتفصَّى من تكاليف هذه الدعوة وتتفلت، وتتخفى في أزياء كثيرة، وهي تخالف عنها، ولا تستقيم عليها، والداعية لا زادَ له إلا الصبرُ أمام هذا كله، والذِّكرُ وهو قرين الصبر في أكثر المواضع في القرآن.
إنه حريٌّ بأهل الإسلام أن يتأسَّوا بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في التخلُّق بالصبر، فلا يحرفهم عن دين الحق وعدُ الكافرين ووعيدُهم، ولا ترغيب المنافقين وترهيبهم، فكلُّ ذلك يزول كما زالت قريشٌ وشِرْكها، وكما زال ابن سلول ونفاقه، وثبتت دعوة الإسلام شامخةَ البنيان، قوية الأركان، وإن رغمت أنوف أهل الكفر والنفاق.
إنَّ الذين يضعفون أمامَ الحملات المنظمة التي يشنها الكُفَّار والمنافقون على الإسلام وشعائره ومناهجه ودعاته - يضرُّون أنفسهم ولن يضروا دين الله - تعالى - شيئًا، وإن الذين يُحرِّفون دين الله - تعالى - ليرضوا به الناس، ولينالوا به عَرَضًا من الدنيا سيرتد تحريفهم عليهم، وسيتحمَّلون أوزارَ من اتَّبعوهم في ضلالِهم، وسيبقى دينُ الله - تعالى - عزيزًا كما كان؛ لأنَّ الله - تعالى - هو من تولَّى حفظه، ولم يَكِلْ ذلك لأحد من خلقه؛ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].
وإنَّ من عظيم مجالات الصبرِ في الإسلام: الصبرَ عما أحدثه المبتدعة في دين الله - تعالى - وإن زخرفوا باطلَهم، ودعوا الناس إليه، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومَحبة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هي في اتِّباعه وطاعته، والتزام سُنَّته، وليست في إحداث الموالد البدعية، والاحتفالات الموسمية بميلاده - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو إسرائه أو هجرته أو غير ذلك، كما أنَّ من الصبر في الدعوة بيانَ الحق في هذه البِدَع والضَّلالات، وعدم مُداهنة أحد فيها كائنًا من كان، مع الصبر على الأذى في ذلك، فإنَّ أهل البدعة في الدين لا بد أن يُلصقوا بالمتمسكين بالسنة تُهمَ التشدد والانغلاق والتطرف، وغير ذلك من الألفاظ التي يسكُّها الكفار، ويُسوِّقُها المبتدعة والمنافقون، ولا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا الحق وأهله؛ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 31 - 32].
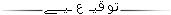
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|